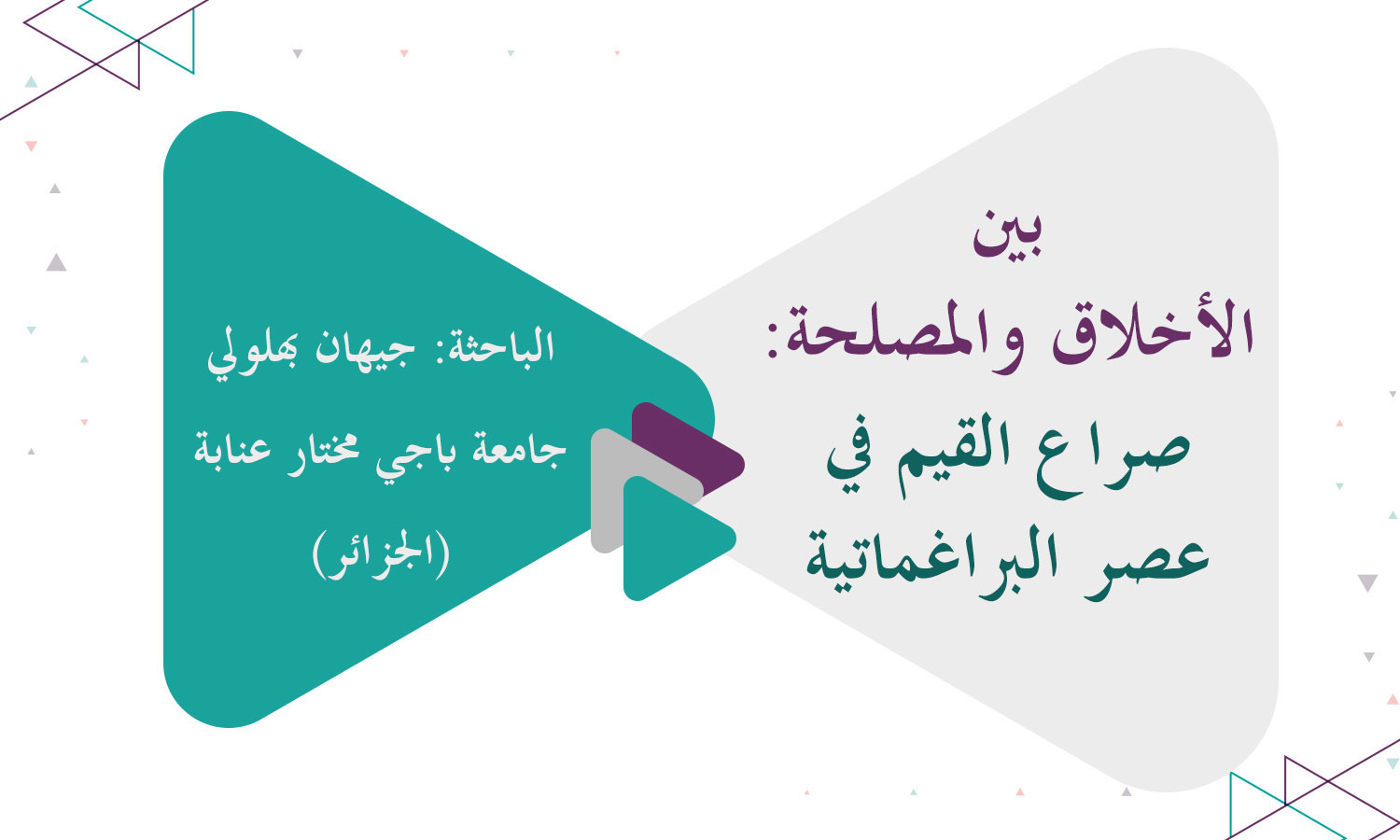بين الأخلاق والمصلحة: صراع القيم في عصر البراغماتية
الباحثة: بهلولي جيهان، جامعة باجي مختار عنابة (الجزائر)
تخصّص: الفلسفة التطبيقية
مقدمة:
يشهد المجتمع المعاصر تزايدًا ملحوظًا في حدّة الصراع بين القيم الأخلاقية من جهة، ومنطق المصلحة الفردية الضيّقة من جهة أخرى. فالتغيّرات الاقتصادية المتسارعة، والتحوّلات الاجتماعية والثقافية العميقة، أدّت إلى اضطراب في سلّم القيم، وظهور ممارسات تُعلي من شأن الكسب السريع والمنفعة الذاتية على حساب المبادئ التي يفترض أن تنظّم العلاقات بين الأفراد.
وقد أصبح الفرد اليوم يعيش بين خطاب اجتماعي يدعو إلى النزاهة، التضامن، الاحترام، وتقديم المصلحة العامة، وبين واقع يومي يبرز فيه السلوك النفعي على نطاق واسع، حتى غدا الكثيرون يتساءلون عن جدوى التمسّك بالقيم في عالم تحكمه المصالح. هذا التناقض لا يقتصر على فئة معيّنة، بل يمسّ مختلف شرائح المجتمع، ويظهر في الممارسات الاقتصادية والعلائقية والثقافية، حيث تتراجع بعض القيم التقليدية أمام ضغوط الحاجة أو إغراء المكاسب.
إنّ خطورة هذا الصراع تكمن في كونه لا يهدد القيم ذاتها فحسب، بل يهدد أيضًا الثقة داخل المجتمع، إذ تتآكل الروابط الاجتماعية عندما تصبح المصلحة معيارًا وحيدًا للسلوك. ومن هنا تبرز أهمية فهم طبيعة هذا الصراع، وأسبابه، وتمظهراته في الواقع، وكيف يمكن للمجتمع أن يحافظ على توازنه القيمي في ظل التحولات التي يمر بها.
مفتتح إشكالي:
في خضم الحياة اليومية المزدحمة، حيث تتسارع الأحداث وتتشابك العلاقات وتزداد المطالب العملية، يجد الإنسان نفسه أمام صراع دائم بين ما يفرضه عليه ضميره وما تقتضيه المصلحة أو المنفعة. فالنجاح المهني، والفرص السريعة، والمكاسب المادية قد تبدو مغرية أكثر من التمسك بالواجب الأخلاقي، ما يجعل الإنسان أمام اختبار حقيقي لقدرة ضميره على الصمود. فهل يمكننا حقًا الحفاظ على المبادئ والقيم وسط عالم يُقاس غالبًا بالنتائج العملية والنجاحات الفورية؟
تزداد حدة هذا الإشكال عندما نلاحظ أن التجربة اليومية تثبت أن الناس كثيرًا ما يتنازلون عن القيم مقابل الراحة أو المكسب، بينما تشير الفلسفة الأخلاقية إلى أن الالتزام بالواجب لا يتوقف على النتائج. فمثلاً، يرى أرسطو أن الفضائل الأخلاقية تتحقق بالممارسة اليومية، أي أن العمل المستمر والممارسة العملية هما الطريق لتثبيت الأخلاق، بينما يرى كانط أن الفعل الأخلاقي الصحيح لا يُقاس بالمنفعة أو النتائج، بل بما يتوافق مع الواجب الأخلاقي ذاته، بغض النظر عن المكاسب.
من هنا يبرز السؤال الإشكالي الذي يثير العقول: هل يمكن للإنسان أن يحافظ على الأخلاق والضمير وسط ضغوط منطق المصلحة وسرعة المكاسب العملية، أم أن الواقع اليومي يجعل من الصعب التمسك بالقيم دون تنازلات؟ وكيف يمكن للفرد أن يوازن بين متطلبات الحياة العملية وبين التزامه بالمبادئ الأخلاقية التي تُشكل جوهر إنسانيته؟
معنى الأخلاقِ:
- لُغةً:
الأخلاقُ جَمعُ خُلُقٍ، والخُلقُ -بضَمِ اللَّامِ وسُكونِها- هو الدِّينُ والطَّبعُ والسَّجيَّةُ (وهو ما خُلِقَ عليه مِنَ الطَّبعِ) والمُروءةُ، وحَقيقةُ الخُلُقِ أنَّه لصورةِ الإنسانِ الباطِنةِ، وهي نَفسُه وأوصافُها ومَعانيها المُختَصَّةُ بها بمَنزِلةِ الخَلقِ لصورَتِه الظَّاهرةِ وأوصافِها ومَعانيها (الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ص881)
وقال الرَّاغِبُ: (والخَلقُ والخُلقُ في الأصلِ واحِدٌ... لكِن خُصَّ الخَلقُ بالهَيئاتِ والأشكالِ والصُّورِ المُدرَكةِ بالبَصَرِ، وخُصَّ الخُلُقُ بالقوى والسَّجايا المُدرَكةِ بالبَصيرةِ)(الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ص297)
وحَقيقةُ الخُلُقِ في اللُّغةِ: هو ما يَأخُذُ به الإنسانُ نَفسَه منَ الأدَبِ، يُسَمَّى خُلُقًا؛ لأنَّه يَصيرُ كالخِلقةِ فيه.
ـ مَعنى الأخلاقِ اصطِلاحًا:
عَرَّف الجُرجانيُّ الخُلُقَ بأنَّه: (عِبارةٌ عن هَيئةٍ للنَّفسِ راسِخةٍ تَصدُرُ عنها الأفعالُ بسُهولةٍ ويُسرٍ من غَيرِ حاجةٍ إلى فِكرٍ ورَويَّةٍ، فإن كان الصَّادِرُ عنها الأفعالَ الحَسَنةَ كانتِ الهَيئةُ خُلُقًا حَسَنًا، وإن كان الصَّادِرُ منها الأفعالَ القَبيحةَ سُمِّيَتِ الهَيئةُ التي هي مَصدَرُ ذلك خُلُقًا سَيِّئًا) (الجرجاني، كتاب التعريفات، ص101)
وعَرَّفه ابنُ مِسكَوَيهِ بقَولِه: (الخُلُقُ: حالٌ للنَّفسِ داعيةٌ لها إلى أفعالِها من غَيرِ فِكرٍ ولا رَويَّةٍ، وهذه الحالُ تَنقَسِمُ إلى قِسمَينِ: منها ما يَكونُ طَبيعيًّا من أصلِ المِزاجِ، كالإنسانِ الذي يُحَرِّكُه أدنى شَيءٍ نَحوَ غَضَبٍ، ويَهيجُ من أقَلِّ سَبَبٍ، وكالإنسانِ الذي يَجبُنُ من أيسَرِ شَيءٍ، أو كالذي يَفزَعُ من أدنى صَوتٍ يَطرُقُ سَمعَه، أو يَرتاعُ من خَبَرٍ يَسمَعُه، وكالذي يَضحَكُ ضَحِكًا مُفرِطًا من أدنى شَيءٍ يُعجِبُه، وكالذي يَغتَمُّ ويَحزَنُ من أيسَرِ شَيءٍ يَنالُه. ومنها ما يَكونُ مُستَفادًا بالعادةِ والتَّدَرُّبِ، ورُبَّما كان مَبدَؤُه بالرَّويَّةِ والفِكرِ، ثمَّ يَستَمِرُّ أوَّلًا فأوَّلًا، حتَّى يَصيرَ مَلَكةً وخُلُقًا) (ابن مِسْكويه، أحمد بن محمد بن يعقوب، تهذيب الأخلاق، ص 41)
وقال السُّيوطيُّ: (الخُلُقُ: مَلَكةٌ نَفسانيَّةٌ تَصدُرُ عنها الأفعالُ النَّفسانيَّةُ بسُهولةٍ من غَيرِ رَويَّةٍ.
وقيل: هو اسمٌ جامِعٌ للقوى المُدرَكةِ بالبَصيرةِ، وتُجعَلُ تارةً للقوى الغَريزيَّةِ، وتارةً للحالةِ المُكتَسَبةِ التي بها يَصيرُ الإنسانُ خَليقًا أن يَفعَلَ شَيئًا دونَ شَيءٍ) (السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، ص197)
وقيل: (الخُلُقُ صِفةٌ مُستَقِرَّةٌ في النَّفسِ -فِطريَّةٌ أو مُكتَسَبةٌ- ذاتُ آثارٍ في السُّلوكِ مَحمودةٍ أو مَذمومةٍ)
وقد عَرَّف بَعضُ الباحِثينَ الأخلاقَ في نَظَرِ الإسلامِ بأنَّها عِبارةٌ عن (مَجموعةِ المَبادِئِ والقَواعِدِ المُنَظِّمةِ للسُّلوكِ الإنسانيِّ، التي يُحَدِّدُها الوَحيُ؛ لتَنظيمِ حَياةِ الإنسانِ، وتَحديدِ علاقَتِه بغَيرِه على نَحوٍ يُحَقِّقُ الغايةَ من وُجودِه في هذا العالَمِ على أكمَلِ وَجهٍ) . وأمَّا الأخلاقُ كعِلمٍ فقد عُرِّفت بعِدَّةِ تَعريفاتٍ، منها:
1- هو (عِلمٌ: مَوضوعُه أحكامٌ قِيَميَّةٌ تَتَعلَّقُ بالأعمالِ التي توصَفُ بالحُسنِ أوِ القُبحِ) (مجموعة مؤلفين. المعجم الوسيط،ص 252)
2-وقيل هو: (عِلمٌ: يوضِّحُ مَعنى الخَيرِ والشَّرِّ، ويُبَيِّنُ ما يَنبَغي أن تَكونَ عليه مُعامَلةُ النَّاسِ بَعضِهم بَعضًا، ويَشرَحُ الغايةَ التي يَنبَغي أن يَقصِدَ إليها النَّاسُ في أعمالِهم، ويُنيرُ السَّبيلَ لِما يَنبَغي) (أمين أحمد. كتاب الأخلاق.ص8)
ومنه نقول: إنَّ الخُلُق هو صفةٌ ثابتة في النفس تُوجِّه السلوك تلقائيًّا نحو الحسن أو القبيح، وهو إمّا فطري يولد مع الإنسان وإمّا مكتسَب بالتربية، بينما تمثّل الأخلاق في الإسلام المبادئ التي يحدّدها الوحي لضبط سلوك الإنسان، ويأتي علم الأخلاق ليدرس معايير الخير والشر ويبيّن ما ينبغي أن يكون عليه الفعل الإنساني.
المصلحة(المنفعة):
ـ لغة:
الجمع: مَصْلحات ومَصالِحُ. المَصْلَحَةُ: الصَّلاَحُ
المَصْلَحَةُ: المنفعةُ
المَصْلَحَةُ: ما فيه صلاح شيء أو حال
المَصْلَحَةُ: هيئة إدارية فرعيه من وزارة تتولي مِرفَقاً عامَّاً
تضاربت المصالحُ: تعارضت،
زواج مصلحة: زواج يُعقد طمعًا في كسب اجتماعيّ أو سياسيّ أو اقتصاديّ
المصلحة هي: "المنفعة والصلاح"، وأيضًا اسم له هيئة إدارية فرعية من وزارة تتولى مرفقًا عامًا.
المصلحة للتعبير عن الخير والصواب، وعبارة "في الأمر مصلحة" تعني أي خير. (مجموعة مؤلفين، المعجم الوسيط، ص874)
معجم المعاني الجامع: المصلحة جمعها مصالح أو مصلحات، وتعني ما يحقق صلاح الحال أو الشيء. وعندما تضاربت المصالح، فهذا يعني تعارضها. والمصلحة مناسبة للحكم بتحصيل المنفعة أو دفع الضرر، أي جلب منفعة أو دفع ضرر معين. مثال: "صلح له الأمر" أي كان مناسبًا ونافعًا، و"صلح الشيء" أي كان مناسبًا ونافعًا.(مروان العطية، المعجم الجامع، ص 215)
المصلحة هي: "ما يتعاطاه الإنسان من أعمال باعثة على النفع".
أما المصلحة العامة فهي رفاهية الجميع، أي جماعة من الناس تجمعها قضية مشتركة.
ـ اصطلاحا:
المصلحة أو منفعة مذهب أخلاقي اجتماعي لا ديني، يجعل من نفع الفرد والمجتمع مقياساً للسلوك، وأن الخير الأسمى هو تحقيق أكبر سعادة لأكبر عدد من الناس.(علي عبد الهادي المرهج، الفلسفة البراجماتية، ص17)
وفي مجال الاقتصاد يقرر مذهب المنفعة أن قيمة السلعة تتوقف على قدر منفعتها وليس على نفقة العمل أو التكلفة.(علي محمد شميش، مفهوم السياسة الخارجية دراسة الأهداف والوسائل، ص 31)
ومنه فإن صواب أي عمل من الأعمال، إنما يحكم عليه بمقدار ما يسهم في زيادة السعادة الإنسانية أو في التقليل من شقاء الإنسان، بصرف النظر عن السداد الأخلاقي لقاعدة ما، أو مطابقتها للوحي أو للسلطة أو للتقليد أو للحس الأخلاقي أو للضمير.
ضغوط الحياة اليومية وأثرها على الأخلاق
في حياتنا اليومية، يواجه الإنسان ضغوطًا كبيرة نتيجة السرعة والإنتاجية والمنافسة، ما يجعل التمسك بالقيم الأخلاقية أمرًا صعبًا، إذ تميل القرارات غالبًا إلى تقييم النتائج العملية أكثر من المبادئ، وقد يؤدي ذلك إلى اختيار ما هو مفيد أو مربح على المدى القصير، حتى لو كان ذلك يتعارض مع الصواب أو الصدق.
يشير الفيلسوف جون ستيوارت ميل إلى أن تصرفاتنا يجب أن تسعى لتحقيق أكبر فائدة ممكنة للآخرين، أي أن الفعل الصحيح هو الذي يؤدي إلى نتائج مفيدة لأكبر عدد من الناس، فالمنفعة هي معيار الصواب، وقد يعني ذلك أن الإنسان أحيانًا يضحي بمبدأ شخصي أو يوافق على تنازلات إذا كان ذلك يخدم خيرًا أكبر للآخرين. (جون ستيوارت ميل، النفعية، ص31)
بالمقابل، يرى إيمانويل كانط أن الواجب الأخلاقي يفرض نفسه على الإنسان مهما كانت النتائج، أي أن الصواب لا يعتمد على النتائج أو المكاسب العملية، بل على الالتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية الثابتة، حتى لو أدى ذلك إلى خسائر شخصية أو صعوبات (إيمانويل كانط، نقد العقل العملي،ص 258)
ويتضح هذا الصراع في مواقف حياتية واقعية، مثل موظف يُطلب منه زيادة أرباح الشركة عبر أساليب غير صادقة، مثل تضخيم الإعلانات أو إخفاء معلومات مهمة عن الزبائن، رغم معرفته أن ذلك يخالف الصدق والأمانة، وهنا يختبر الموظف قدرته على الموازنة بين المصلحة الشخصية أو مصلحة الشركة وبين الواجب الأخلاقي الذي يفرض عليه التصرف بنزاهة.
من هذا المثال، يظهر التناقض بين موقف الفلسفة البراغماتية التي تركز على النتائج العملية والفائدة الملموسة، وموقف الفلسفة الأخلاقية القائمة على الواجب التي تركز على الالتزام بالمبادئ والقيم، إذ يجد الإنسان نفسه أمام اختبار مستمر لقدرة ضميره على الصمود وسط ضغوط الحياة اليومية، وعليه أن يقرر: هل يتبع منطق المصلحة والمنفعة، أم يلتزم بالواجب الأخلاقي رغم الصعوبات؟ هذا السؤال يفتح المجال للتفكير في طبيعة الأخلاق وكيفية التوازن بين ما هو عملي وما هو أخلاقي.
أخلاق أم مصلحة: قصص من الواقع
الصراع بين المصلحة والواجب يظهر في كثير من مجالات حياتنا مثل السياسة والاقتصاد والطب، أي في القرارات التي تؤثر على الناس والمجتمع. يرى نيكولو ماكيافيلي أن القائد قد يحتاج أحيانًا لاتخاذ قرارات صعبة تخالف القيم الأخلاقية إذا كان ذلك ضروريًا لحماية الدولة والحفاظ على استقرارها. (ماكيافيلي، الأمير، ص19)، بينما يرى إيمانويل كانط أن الواجب الأخلاقي يجب أن يكون دائمًا هو المعيار، مهما كانت النتائج، فلا يمكن تبرير انتهاك المبادئ لأجل أي غرض عملي. (إيمانويل كانط، نقد العقل العملي، ص 265)
ويتضح هذا الصراع في مواقف حياتية واقعية. ففي الطب، قد يحتوي مستشفى على موارد محدودة من الأدوية المنقذة للحياة، ويأتي مريض فقير يحتاج إلى علاج مكلف، بينما يمكن علاج مجموعة من المرضى الآخرين بنفس الموارد لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، وهنا يظهر صراع بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة. وفي الأعمال، قد تضطر شركة لتسريح بعض الموظفين لتجنب الإفلاس والحفاظ على مستقبل المؤسسة، لكنها بذلك تخالف الواجب الأخلاقي تجاه حقوق الأفراد. أما في السياسة، فقد يُفرض حظر تجوال أثناء أزمة صحية لحماية المجتمع، مثل منع الناس من التحرك بحرية أو الاجتماع لتجنب انتشار مرض معدٍ، وهذا الإجراء يحقق المصلحة العامة عبر حماية أغلبية السكان، لكنه يقيد حرية بعض الأفراد الذين لا يشكلون تهديدًا مباشرًا، ومنه تبرر النفعية مثل هذه القرارات إذا زادت السعادة العامة، لكنها قد تتجاهل حقوق الأفراد، بينما تحذر الفلسفة الكانطية من تجاوز الواجب الأخلاقي مهما كانت النتائج. وكما نجد هابرماس يضيف بعدًا آخر عبر مفهوم العقلانية الأداتية، حيث يصبح التركيز على الوسائل لتحقيق الهدف أهم من القيم، مما قد يهدد المبادئ إذا لم يرافقه وعي أخلاقي، أي أن الاهتمام بالنتائج فقط دون مراعاة القيم قد يؤدي إلى تآكل الأخلاق واضمحلالها.
هل تضر مصلحتي بالآخرين؟
سعي الفرد لتحقيق مصالحه الشخصية قد يؤدي أحيانًا إلى تجاهل القيم والمبادئ الأساسية، أي أن التركيز على المكاسب الفردية على حساب الأخلاق يضعف التماسك الاجتماعي ويؤثر على الثقة بين الناس، إذ يصبح الانتماء للمجتمع أقل تأثيرًا على سلوك الفرد مقارنة بالمصلحة الشخصية الفورية.
يمكن ملاحظة ذلك في مواقف يومية عديدة، مثل الطلاب الذين يغشون أو يشترون بحوثًا جاهزة للحصول على درجات عالية بسهولة، أو الشركات التي تخدع العملاء لتحقيق أرباح أكبر، أو الأشخاص الذين يتأخرون في الوفاء بالتزاماتهم المالية الصغيرة لمصلحة شخصية قصيرة المدى، وحتى أولئك الذين يستغلون الآخرين لإنجاز مهامهم فقط ليحصلوا على مكافآت أو ترقيات دون الاعتراف بمساهمات الآخرين، ما يخلق بيئة عمل أو دراسة تتسم بالأنانية وتضعف الروابط الاجتماعية.
من الناحية الفلسفية، تحذر العقلانية الأداتية عند هابرماس من أن التركيز على النتائج فقط يجعل البشر أدوات لتحقيق مصالح شخصية، مما يؤدي إلى تراجع أهمية القيم الأخلاقية والمبادئ المشتركة، ويقلل من احترام الحقوق الأساسية للآخرين، كما أنه يضعف الالتزام بالقوانين والمعايير الاجتماعية الضرورية لاستقرار المجتمع ، من جهة أخرى، قد تبرر الفلسفة النفعية بعض هذه التصرفات إذا كانت تؤدي إلى زيادة السعادة العامة، لكنها غالبًا لا تراعي الحقوق الفردية أو المبادئ الأخلاقية الثابتة، وبالتالي قد تؤدي إلى تجاوز القيم الأساسية وإضعاف العدالة بين الناس، إذ يصبح الهدف النهائي - زيادة المنفعة أو السعادة - مبررًا لتجاهل القيم الأساسية، وهو ما يشير إلى ضرورة الموازنة بين النتائج العملية والواجب الأخلاقي. (المعجم الفلسفي، ابراهيم مذكور، ص 32)
بالتالي، يظهر من هذا التحليل أن تركيز الفرد على المصلحة الشخصية على حساب الأخلاق ليس مجرد سلوك فردي بل له آثار اجتماعية واسعة، فهو يهدد الثقة المتبادلة بين الأفراد، ويضعف التضامن الاجتماعي، ويجعل المجتمع أكثر عرضة للتوترات والصراعات، مما يبرز أهمية وجود وعي أخلاقي يوازن بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة.
المصلحة العامة: حدود التضحية بحق الفرد
في بعض الحالات، يحتاج المجتمع إلى اتخاذ قرارات تصب في المصلحة العامة، حتى لو اضطر بعض الأفراد للتخلي عن بعض حقوقهم، إذ قد تتطلب حماية المجتمع وتحقيق منفعة أكبر للجميع التضحية جزئيًا بحقوق الفرد.
فالمصلحة العامة قد تتطلب أحيانًا التضحية بحقوق الفرد من أجل حماية المجتمع وتحقيق منفعة أكبر للجميع، ويظهر ذلك جليًا في القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على حياة الناس بشكل مباشر(علي عبد الهادي المرهج،الفلسفة البراجماتية،ص47)ومن الأمثلة الواقعية على ذلك: فرض ضرائب على الأغنياء لتمويل برامج وخدمات عامة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص متساوية، وهو إجراء يوازن بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة.
كما يمكن أن تشمل الإجراءات تطبيق قيود صحية أثناء الأوبئة لحماية الناس من الأمراض المعدية، وهو ما يوضح صراعًا بين حماية المجتمع ككل وبين حرية الأفراد، حيث تُفرض قيود مؤقتة على التنقل أو التجمعات العامة لضمان سلامة أغلبية السكان وأيضًا، إقامة مشاريع بنية تحتية كبيرة قد تتطلب إخلاء بعض السكان مؤقتًا لضمان تنفيذ المشروع بما يخدم الصالح العام، أو وضع قوانين المرور والسلامة لحماية الجميع من الحوادث المحتملة، أو تنظيم أوقات العمل والدراسة للأطفال للحفاظ على صحتهم وتطويرهم الجسدي والفكري، أو حظر بعض المواد الضارة لصالح المجتمع.
توضح هذه الأمثلة أن التركيز على المصلحة العامة قد يبرر أحيانًا تجاوز حقوق الفرد، لكن من الضروري وضع حدود واضحة لهذه التضحية لضمان العدالة وحماية حقوق كل شخص، بحيث يكون هناك توازن دائم بين الصالح العام وحقوق الأفراد. إذ إن الفلسفة النفعية تقدم إطارًا لتقييم هذه القرارات على أساس المنفعة الأكبر الممكنة، بينما الفلسفة الكانطية تؤكد ضرورة احترام الواجب الأخلاقي وحقوق الفرد حتى عند اتخاذ قرارات تصب في الصالح العام، وهو ما يبرز أهمية الدمج بين الالتزام بالقيم الأخلاقية ومراعاة المصلحة العامة لتحقيق مجتمع عادل ومستقر.
هل تصمد المبادئ أمام ضغوط المجتمع؟
الصراع بين الأخلاق والمصلحة يظهر بوضوح في حياتنا اليومية، فهو ليس مجرد فكرة نظرية، بل واقع نعيشه كل يوم. يمكن ملاحظته في الفضائح السياسية، التسويق المضلل، التهرب الضريبي، أو حتى الكذب لتجنب المشاكل، حيث يختار بعض الأشخاص مصالحهم على حساب واجباتهم تجاه الأسرة والمجتمع، مما يبرز الحاجة إلى التربية الأخلاقية والوعي الاجتماعي كأداة أساسية لمساعدة الإنسان على التمييز بين ما هو صواب وما هو مصلحة شخصية قصيرة المدى.
ومن وجهة نظر الفلاسفة، ترى النفعية أن القرارات الصحيحة هي التي تحقق أكبر منفعة لأكبر عدد من الناس، وهو ما قد يضع المبادئ الفردية أمام اختبار صعب، إذ قد تضطر بعض المؤسسات أو الأفراد إلى تجاوز القيم الأخلاقية إذا كانت النتائج تخدم الصالح العام.
بينما يؤكد جون لوك (John Locke) أن احترام حقوق الآخرين والالتزام بها هو أساس الفعل الأخلاقي، مما يعني أن المبادئ يجب أن تصمد أمام الضغوط المجتمعية، وأن الإنسان لا يجوز له تجاوز الواجب الأخلاقي لمجرد تحقيق مكاسب مؤقتة أو لتجنب العقوبات الاجتماعية (جون لوك، رسالة في التسامح، ص64).
ويرى جان جاك روسو (Jean-Jacques Rousseau) أن المجتمع أحيانًا يفرض ضغوطًا قوية على الفرد قد تجعله يبتعد عن طبيعته الأخلاقية، لذا فإن قوة الالتزام بالمبادئ هي ما يحدد قدرة الإنسان على مقاومة هذه الضغوط. (جان جاك روسو، العقد الاجتماعي، ص55)
كما نجد بيتر سينجر (Peter Singer) يشير إلى أن المبادئ الأخلاقية لا تصبح فعالة إلا إذا انعكست في أفعال يومية ملموسة، وأن الإنسان قد يُجبر أحيانًا على التضحية الشخصية من أجل تقليل معاناة الآخرين، وهذا الاختبار هو ما يظهر مدى صمود القيم أمام الضغط العملي والاجتماعي ، ويضيف أرسطو (Aristotle) أن الفضائل تُكتسب بالممارسة المستمرة، وأن القدرة على التمسك بالمبادئ الأخلاقية أمام ضغوط المجتمع تتطلب تدريبًا دائمًا، لأن الإنسان يصبح أخلاقيًا بالفعل فقط عندما يواجه مواقف الحياة اليومية بتكرار ممارسة الخير والصدق والعدالة.(أرسطو، علم الأخلاق إلى النيقوماخوس، ص64)
ومنه، في الممارسة العملية يمكن ملاحظة أن المبادئ تصمد عند المؤسسات والأفراد الذين يضعون الأخلاق في صميم قراراتهم، مثل الشركات التي تلتزم بالمعايير البيئية أو المستشفيات التي توزع الموارد بعدل، إذ إن قوة المبادئ هي التي تحميهم من الانحراف تحت ضغوط الربح أو التنافس.
خاتمة:
في النهاية، يظل الصراع بين الأخلاق والمصلحة من أبرز التحديات التي تواجه الإنسان في حياته اليومية، سواء على المستوى الفردي أو الاجتماعي. فالأخلاق تشكل البوصلة التي تهدي السلوك البشري، وتحدد ما هو صحيح وما هو خطأ، بينما تدفع المصلحة أحيانًا نحو الانحراف عن هذه المبادئ، تحت ضغط الرغبة في المكاسب الشخصية أو النجاة في بيئات تنافسية. ويمكن ملاحظة ذلك في كثير من المواقف اليومية؛ فمثلاً، الأطباء الذين يرفضون الرشاوى لضمان تقديم رعاية عادلة، رغم الضغوط المالية المحيطة بهم، يظهرون التفافًا على منطق المصلحة الفورية لصالح التمسك بالمبادئ الأخلاقية. أما في المجال السياسي أو الاقتصادي، فقد نرى المسؤولين أو رجال الأعمال الذين يختارون اتخاذ قرارات تخدم مصالحهم الذاتية على حساب الصالح العام، ما يسلط الضوء على الصراع الداخلي بين ضمير الإنسان وواقعه العملي. ويبقى السؤال محوريًا ومفتوحًا: هل يمكن للأخلاق أن تظل دائمًا أقوى من منطق المصلحة في عالم يزداد فيه ضغط البراغماتية والمصالح العملية، أم أن الإنسان سيجد نفسه مضطرًا أحيانًا لتسوية مبادئه من أجل البقاء أو التقدم؟ هذا التساؤل يعكس عمق التحدي الذي يواجه كل فرد، ويجعل من دراسة العلاقة بين الأخلاق والمصلحة ضرورة لفهم سلوك الإنسان في المجتمع الحديث، سواء على مستوى القيم الشخصية أو السياسات العامة.
قائمة المصادر والمراجع:
من المعاجم:
الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب،القاموس المحيط. بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، الطبعة 8. 2005
إبراهيم مذكور، معجم اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية،القاهرة، د ط،1983.
الجرجاني، كتاب التعريفات ، دار لبنان، بيروت، الطبعة 1، 1985
الراغب الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن الكريم. تحقيق: صفوان عدنان داوودي. دمشق - بيروت: دار القلم ،ط 4، 2009
مجموعة مؤلفين. المعجم الوسيط. القاهرة: مجمع اللغة العربية . القاهرة ،ط2، 1972
مروان العطية، المعجم الجامع، دار النوادر، القاهرة، الطبعة الأولى، 2013
السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم. القاهرة: مكتبة الآداب، الطبعة الأولى، 2004
من المصادر:
إيمانويل كانط، نقد العقل العملي،ترجمة غانم هنا، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، الطبعة 1، 2008.
جون ستيوارت ميل، النفعية، ترجمة سعاد شاهرلي حرار، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط1 ،2012.
ماكيافيلي، الأمير، ترجمة أكرم مؤمن، مكتبة إبن سينا للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2004 .
أرسطو، علم الأخلاق إلى النيقوماخوس، ترجمة أحمد لطفي السيد، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، الطبعة 2، 1924.
جان جاك روسو، العقد الاجتماعي، ترجمة عادل زعيتر، مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2013.
جون لوك، رسالة في التسامح، ترجمة منى أبو سنه، المجلس الأعلى للثقافة، الإسكندرية، ط1 ،1997 .
من المراجع:
علي عبد الهادي المرهج،الفلسفة البراجماتية، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط1، 2008
أمين أحمد. كتاب الأخلاق. القاهرة: دار العالم العربي، الطبعة الأولى، 2020
ابن مِسْكويه، أحمد بن محمد بن يعقوب. تهذيب الأخلاق. القاهرة: مؤسسة هنداوي .2024
من المجلات:
علي محمد شميش، مفهوم السياسة الخارجية دراسة الأهداف والوسائل، مجلة دراسات في الاقتصاد والتجارة، المجلد09، العدد 02، كلية الاقتصاد والتجارة، جامعة قار يونس، بنغازي، ليبيا، 1975.