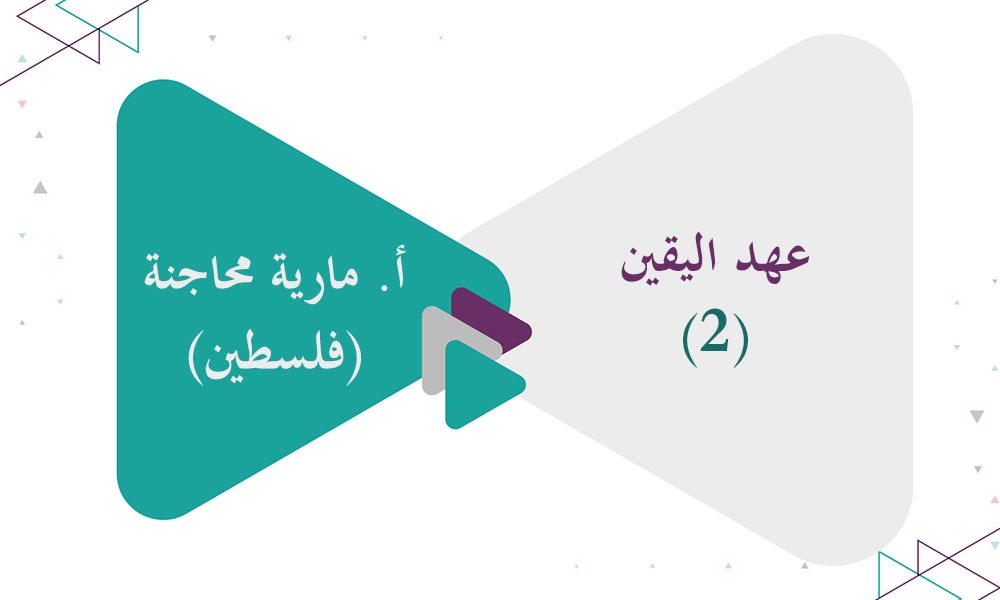شغف الإنسان، منذ فجر الحضارة، بالسعي الدؤوب للبحث في ماضيه لفهم حاضره واستشراف مستقبله. وقد تولَّد عن تلك المحاولات الحثيثة نشأةُ علم التاريخ، الذي يُعَدّ أقدم العلوم الإنسانية. لكن رحلة هذا العلم، التي استُهلَّت بجمع الوقائع المادية وفحصها وتركيبها في سردٍ منهجيٍّ قائمٍ على الأدلة وموثَّقٍ للأحداث، والتي أُوكِلت مهمتها للمؤرِّخ، ولَّدت أسئلةً أعمق وتأمّلاتٍ أبلغ أُوكِلت مهمتها للفلاسفة.
وقد دارت هذه التساؤلات أساسًا حول ماهيّة الأحداث التاريخية، وتفسير حركتها، والكشف عن قوانينها، وبيان غايتها ومقاصدها. وهو ما عُرِف بفلسفة التاريخ. وسنعرض في هذا المقال مجال التباين بين العِلمين قبل أن نعرِّج على الأهمية والدور.
التباين والفروق
يتميز علم التاريخ بصفته حرفةً وأداةً للبحث، يسعى جاهدًا للإجابة عن سؤال: ماذا حدث؟ وكيف حدث؟
أداته في ذلك المصادر المادية من وثائق ومخطوطات ومرويات، أو ما يُعثر عليه من حفريات. أما غايته فهي إعادة بناء الأحداث بتسلسل منهجي يمكن أن يُحفظ في الذاكرة البشرية ويشكّل وعيها بماضيها، متقصيًا في ذلك أدق التفاصيل الجزئية.
أما فلسفة التاريخ فتتبع، بصفة نظرية وتأملية، مسار الأحداث والوقائع التاريخية في محاولة لفهم أسباب حدوثها وكشف القوانين الثاوية خلفها، وذلك من خلال الإجابة عن سؤالي: لماذا حدث؟ وإلى أين نتجه؟
وعليه، فهي بذلك تتخذ من تفسير حركة المجتمعات والسنن التي تحكمها وظيفةً، ومن الاعتماد على التحليل الفلسفي والنقد للظواهر أداةً. وهو ما يقتضي أن يكون نطاقها مهتمًّا بالكليات والأنماط الكبرى، لا بجزئيات الأحداث وتفاصيلها، على عكس مهمة المؤرخين.
الأهمية والدور
إذا كان التاريخ يساعدنا على تفسير حاضرنا من خلال معرفة ماضينا، فإن أهمية فلسفة التاريخ تتجلى في أنها تمنحنا وعياً نقدياً لتجاربنا، وتساعدنا على استخلاص سنن الماضي، كما تُسهم في بناء رؤية مستقبلية تتجاوز السرد الوقائعي إلى البحث عن العبر والدروس.
وكما اختلف المؤرخون في صحة أو دقة بعض الأحداث والوقائع التاريخية، فقد تباين الفلاسفة أيضاً في تفسيرهم لحركة التاريخ؛ بين من يرى أنه يسير تصاعدياً نحو غاية محددة، وبين من اعتبره يخضع لدورات متعاقبة من الصعود والانحطاط.
وقد كشف ابن خلدون، في مقدمته التي أرسى فيها أولى بواكير هذا العلم، أن التاريخ في حالة صعود وهبوط، مما يعني أن الأمم تدور فيه بين مراحل متكررة من الازدهار والانحطاط. وهو ما وافقه عليه آرنولد توينبي وأوزفالد شبنغلر. أما هيغل فرأى أن التاريخ يمثل خطاً متصاعداً ينتهي بتحقق الحرية، بينما أصرّ ماركس في حتميته على أن التاريخ يتشكل نتيجة التفاعل بين المادة والعلاقات الاقتصادية بين طبقات المجتمع.
أما في السياق المعاصر، فقد أضاف أستاذنا د. جاسم السلطان إسهاماً قيّماً في كتابه «فلسفة التاريخ»، حيث دعا إلى توظيف هذا الحقل المعرفي في فهم الواقع وبناء النهضة، وذلك من خلال الخروج من مصيدة التاريخ (الدوران في الأخطاء نفسها) إلى أفق التاريخ (التعرّف على الأخطاء بغرض الاعتبار). مبيّناً أن التاريخ مخزن للعبر والسنن التي تكشف عن قوانين التداول الحضاري، والتي من خلالها يمكن للأمة أن تتجنب أخطاء الماضي، وتخطط لمستقبلها بوعي حضاري، لتؤسس مشروعاً جديداً مبنياً على النقد الذاتي والقراءة الموضوعية.
الخاتمة
إنَّ دراسة الحدود الفاصلة بين علم التاريخ وفلسفته، تبيّن كيف أنَّ التاريخ يقدّم لنا ركامًا ضخمًا من الحقائق والوقائع، بينما تقوم فلسفته على بناء نظرية تفسّر هذه الوقائع وتشكل مفتاحًا لصنع مستقبل معتبر بأخطاء الماضي. وعليه، فكلٌّ من العِلمين وجهان لعملة واحدة، يكمل كلٌّ منهما الآخر ليمنحنا رؤية أعمق وأشمل لتجربة الإنسان عبر الزمن، نستخلص منها الدروس والعبر، نفسّر بها الحاضر، ونستشرف بها المستقبل.
المراجع