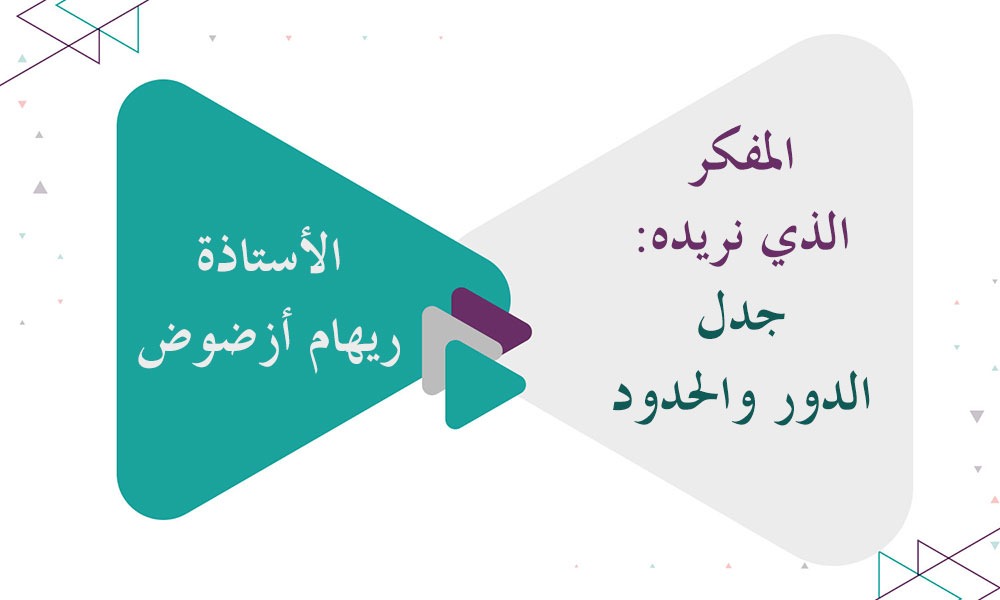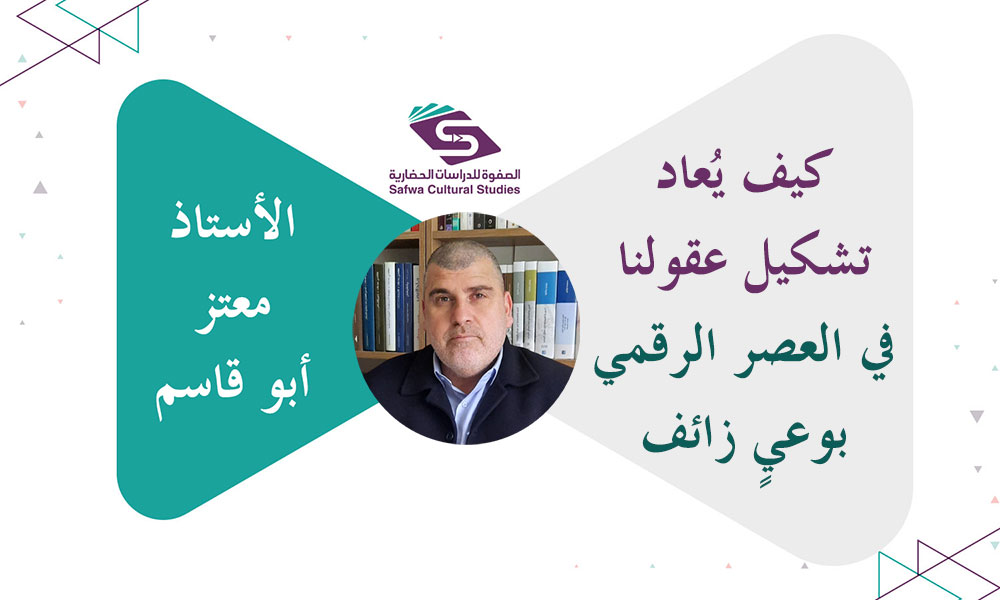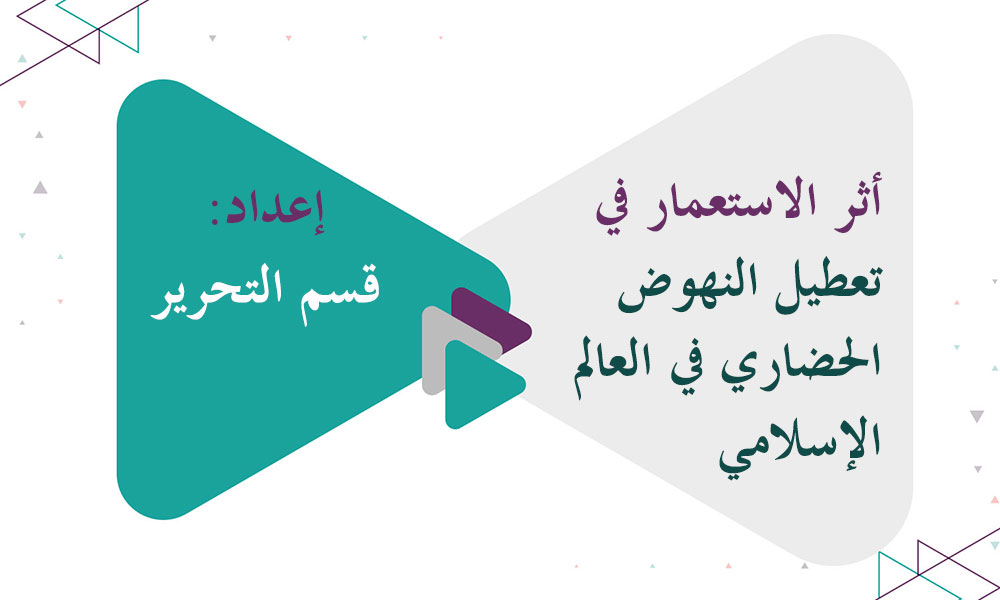شهد العالم الإسلامي خلال القرنين التاسع عشر والعشرين إعادة تشكيلٍ عميقة لبُناه السياسية والاقتصادية والاجتماعية بفعل التوسّع الاستعماري الأوروبي. تشكَّلت أنماط حكمٍ واقتصادٍ وتعليمٍ تُنتج اعتمادًا طويل الأمد على الخارج، وتؤطر سلطةً مركزيةً تُفضِّل الاستخراج على البناء المؤسسي الشامل. تُظهر الأدبيات الاقتصادية أن نماذج الحكم الاستعماري أنشأت مؤسساتٍ “استخراجية” حين كان الاستيطان الأوروبي صعبًا، ما أرسى قواعد تُقيِّد المشاركة والابتكار وتُضعف الاستثمار في رأس المال البشري، بينما ازدهرت “المؤسسات الشاملة” في بيئات مختلفة؛ وهو تفسيرٌ صار من أهم مفاتيح فهم التفاوت في الدخل والنمو على المدى الطويل.
أولًا: الاقتصاد السياسي للاستخراج
داخل مصر مثلًا، أدّى الاحتلال البريطاني (1882-1956) إلى ترسيخ اقتصادٍ أحادي يعتمد على القطن بوصفه مصدرًا رئيسًا للريع والعملة الصعبة. قبيل الحرب العالمية الأولى بلغ القطن نحو 90-93% من الصادرات، ما عنى ربط الريف المصري بالأسواق الأوروبية وتقييد القدرة على تنويع القاعدة الإنتاجية. قادت هذه البنية إلى هشاشةٍ أمام تقلبات الطلب والأسعار، وإلى هيمنة شبكةٍ مالية وتجارية تُموضع مصر في موقع المورّد الأولي بدل المجمَّع الصناعي. تُوثّق دراسات تاريخية واقتصادية هذا التحول بالأرقام، وتعرض كيف ارتفعت حصة القطن من الصادرات إلى نحو 90-93% بين 1910 و1914.
داخل مصر مثلًا، أدّى الاحتلال البريطاني (1882-1956) إلى ترسيخ اقتصادٍ أحادي يعتمد على القطن بوصفه مصدرًا رئيسًا للريع والعملة الصعبة. قبيل الحرب العالمية الأولى بلغ القطن نحو 90-93% من الصادرات، ما عنى ربط الريف المصري بالأسواق الأوروبية وتقييد القدرة على تنويع القاعدة الإنتاجية. قادت هذه البنية إلى هشاشةٍ أمام تقلبات الطلب والأسعار، وإلى هيمنة شبكةٍ مالية وتجارية تُموضع مصر في موقع المورّد الأولي بدل المجمَّع الصناعي. تُوثّق دراسات تاريخية واقتصادية هذا التحول بالأرقام، وتعرض كيف ارتفعت حصة القطن من الصادرات إلى نحو 90-93% بين 1910 و1914.
يتبدّى المنطق ذاته في بقية الأقاليم: أولويةُ المواد الخام، وتوجيه الاستثمارات نحو مرافئ وخطوط نقلٍ تخدم التصدير السريع، وسياساتٌ ضريبية ومالية تؤمِّن تدفق الريع إلى مركز الإمبراطورية. وطبقًا لمدرسة “أصول التنمية الاستعمارية” في الاقتصاد المؤسسي، يخلّف هذا النمطُ مؤسساتٍ تميل إلى تقييد حقوق الملكية الواسعة والتمثيل السياسي، ما ينعكس بطئًا في تراكم رأس المال وتبنّي التكنولوجيا.
ثانيًا: أثر الحدود والترتيبات الدولية
صاغت اتفاقات الحرب العالمية الأولى خرائط الشرق الأوسط الحديثة عبر ترتيباتٍ سرّيةٍ ومعلنة جزّأت الولايات العثمانية ووزّعت مناطق النفوذ. جاءت اتفاقية سايكس-بيكو سنة 1916 نموذجًا محدِّدًا لهذا المسار، إذ حدّدت مجالات السيطرة البريطانية والفرنسية وقسّمت المشرق إلى كياناتٍ تُدار بانتدابٍ مباشر أو نفوذٍ غير مباشر. ترتّبت على ذلك مجتمعاتٌ سياسية حديثة بحدودٍ لا تتوافق أحيانًا مع الشبكات التاريخية للسكان والطرق والتجارة، ما أطلق تنافساتٍ على الموارد والهوية وأطال زمن بناء الدولة الوطنية.
صاغت اتفاقات الحرب العالمية الأولى خرائط الشرق الأوسط الحديثة عبر ترتيباتٍ سرّيةٍ ومعلنة جزّأت الولايات العثمانية ووزّعت مناطق النفوذ. جاءت اتفاقية سايكس-بيكو سنة 1916 نموذجًا محدِّدًا لهذا المسار، إذ حدّدت مجالات السيطرة البريطانية والفرنسية وقسّمت المشرق إلى كياناتٍ تُدار بانتدابٍ مباشر أو نفوذٍ غير مباشر. ترتّبت على ذلك مجتمعاتٌ سياسية حديثة بحدودٍ لا تتوافق أحيانًا مع الشبكات التاريخية للسكان والطرق والتجارة، ما أطلق تنافساتٍ على الموارد والهوية وأطال زمن بناء الدولة الوطنية.
ثالثًا: التعليم واللغة والهوية المعرفية
أنتجت السياسات التعليمية والثقافية الاستعمارية فجواتٍ حادّة في رأس المال البشري. تُظهر حالة الجزائر كيف واجهت العربية والتعليم الأهلي تضييقًا طويلًا، فتدنى معدّل القراءة والكتابة قبيل الاستقلال إلى مستوياتٍ متدنية للغاية، ثم بدأت رحلةُ تعميم التعليم بعد 1962. تشير مصادر تاريخية ومعرفية إلى أنّ المعدّلات الحديثة ارتفعت لاحقًا بصورة كبيرة مع خططٍ وطنية لمحو الأمية وتعريب الإدارة والتعليم. يحمل هذا المثال دلالةً مركزية: الاستثمار المتأخر في التعليم يُنتج تحسّنًا واضحًا، غير أنّ الكلفة الزمنية والاجتماعية كبيرة.
أنتجت السياسات التعليمية والثقافية الاستعمارية فجواتٍ حادّة في رأس المال البشري. تُظهر حالة الجزائر كيف واجهت العربية والتعليم الأهلي تضييقًا طويلًا، فتدنى معدّل القراءة والكتابة قبيل الاستقلال إلى مستوياتٍ متدنية للغاية، ثم بدأت رحلةُ تعميم التعليم بعد 1962. تشير مصادر تاريخية ومعرفية إلى أنّ المعدّلات الحديثة ارتفعت لاحقًا بصورة كبيرة مع خططٍ وطنية لمحو الأمية وتعريب الإدارة والتعليم. يحمل هذا المثال دلالةً مركزية: الاستثمار المتأخر في التعليم يُنتج تحسّنًا واضحًا، غير أنّ الكلفة الزمنية والاجتماعية كبيرة.
رابعًا: الصحة والديموغرافيا والبنية الاجتماعية
رافقت منظومات الاستغلال مشاكلُ صحةٍ عامة واختلالاتُ توزيعٍ للخدمات. تُظهر وثائق ودراسات سوسيولوجية وتاريخية لحقبة الجزائر أرقامًا عن محدودية الأطباء والخدمات، وإرثًا ديموغرافيًا صعبًا تراجعت حدّته تدريجيًا بعد الاستقلال مع تحسن مؤشرات الصحة العامة. يضيء هذا المسار على أثر الأولويات الاستعمارية في توجيه الإنفاق نحو الأمن والإدارة بدل الصحة والتعليم.
رافقت منظومات الاستغلال مشاكلُ صحةٍ عامة واختلالاتُ توزيعٍ للخدمات. تُظهر وثائق ودراسات سوسيولوجية وتاريخية لحقبة الجزائر أرقامًا عن محدودية الأطباء والخدمات، وإرثًا ديموغرافيًا صعبًا تراجعت حدّته تدريجيًا بعد الاستقلال مع تحسن مؤشرات الصحة العامة. يضيء هذا المسار على أثر الأولويات الاستعمارية في توجيه الإنفاق نحو الأمن والإدارة بدل الصحة والتعليم.
خامسًا: العنف البنيوي وتكاليف التحرّر
تحمل تجارب المقاومة والتحرّر كلفةً بشرية واقتصادية جسيمة. يكفي النظر إلى مسار الجزائر بين 1954 و1962 حيث خلّفت الحرب مئات الآلاف من الضحايا، إلى جانب تدميرٍ للبنى الريفية وتعطيلٍ طويلٍ للإنتاج الاجتماعي. يُظهر التأريخ العسكري والمدني حجم العنف منذ بدايات الغزو في القرن التاسع عشر واستمراره بأشكالٍ متعددة حتى الاستقلال، ما أضاف طبقاتٍ من الجراح فوق بنى الاقتصاد والتعليم والإدارة.
سابعًا: انعكاسات طويلة المدى على مؤشرات النمو
تدعم قواعد بيانات التاريخ الاقتصادي (مشروع ماديسون) فكرة “التأخر النسبي” في اللحاق بمعدلات الدخل العالمية خلال القرن العشرين، مع تسجيل تحسنٍ لاحق في بعض الدول بعد موجة التأميمات وبناء الدولة الوطنية، من دون سدّ فجوات الإنتاجية والمعرفة بصورةٍ شاملة. يحمل هذا النمط بصمةَ تاريخٍ مؤسسي تَشكَّل في الحقبة الاستعمارية، ثم استمرّ عبر بيروقراطياتٍ مركزية تعتمد على ريوعٍ محدودة التنوع.
تحمل تجارب المقاومة والتحرّر كلفةً بشرية واقتصادية جسيمة. يكفي النظر إلى مسار الجزائر بين 1954 و1962 حيث خلّفت الحرب مئات الآلاف من الضحايا، إلى جانب تدميرٍ للبنى الريفية وتعطيلٍ طويلٍ للإنتاج الاجتماعي. يُظهر التأريخ العسكري والمدني حجم العنف منذ بدايات الغزو في القرن التاسع عشر واستمراره بأشكالٍ متعددة حتى الاستقلال، ما أضاف طبقاتٍ من الجراح فوق بنى الاقتصاد والتعليم والإدارة.
سابعًا: انعكاسات طويلة المدى على مؤشرات النمو
تدعم قواعد بيانات التاريخ الاقتصادي (مشروع ماديسون) فكرة “التأخر النسبي” في اللحاق بمعدلات الدخل العالمية خلال القرن العشرين، مع تسجيل تحسنٍ لاحق في بعض الدول بعد موجة التأميمات وبناء الدولة الوطنية، من دون سدّ فجوات الإنتاجية والمعرفة بصورةٍ شاملة. يحمل هذا النمط بصمةَ تاريخٍ مؤسسي تَشكَّل في الحقبة الاستعمارية، ثم استمرّ عبر بيروقراطياتٍ مركزية تعتمد على ريوعٍ محدودة التنوع.
ثامنًا: كيف أعاق الاستعمار مشروع النهضة؟
- تقييد التراكم المعرفي: إضعاف الشبكات التعليمية الوطنية وإقصاء لغات العلم المحلية أو محاصرتها، ما يقلّص قاعدة الباحثين والمهنيين ويؤخّر تشكّل “طبقة وسطى معرفية”. يتبدّى ذلك في أرقام الأمية المرتفعة تاريخيًا داخل بلدانٍ مستَعمَرة ثم تحسّنها البطيء بعد الاستقلال.
- اقتصاد أحادي ريعي: هيمنة محصولٍ واحد أو خامٍ واحد ترسّخ هشاشةً بنيوية أمام صدمات الأسعار، وتدفع النخبة الإدارية نحو عقلية الجباية بدل التصنيع والابتكار؛ ومصر القطن نموذجٌ دالّ.
- هندسة الحدود والولاءات: ولادة دولٍ وطنية بحدودٍ مصطنعة جزئيًا قادت إلى أزمات هوية وتمثيل، وأخَّرت ترسيخ عقدٍ اجتماعي جامع.
- عنفٌ تراكمت آثاره: حروب التحرّر وأدوات الضبط الاستعماري خلّفت صدماتٍ اجتماعية وتهجيرًا وترييفًا قسريًا، مع خسائر بشرية واقتصادية عميقة.
- إرثٌ مؤسسي مقيد: قيام إداراتٍ تركِّز على الاستخراج والرقابة يورث بعد الاستقلال نمطًا من الحوكمة يميل إلى المركزية وضعف المساءلة، وفق تفسير الاقتصاد المؤسسي الحديث.
تاسعًا: دروسٌ عملية لاستئناف النهوض
أ) بناء مؤسساتٍ شاملة: تُظهر أبحاثُ الاقتصاد المؤسسي أنّ مسار الازدهار يمرّ عبر توسيع قاعدة الحقوق الاقتصادية والسياسية، وحماية الملكية، وتمكين ريادة الأعمال، وتثبيت حكم القانون. إنّ إصلاحاتٍ تشريعية وقضائية تُعزّز استقلال القضاء وشفافية الموازنة تشكّل رافعةً أساسيةً لأيّ استراتيجية نهضوية.
أ) بناء مؤسساتٍ شاملة: تُظهر أبحاثُ الاقتصاد المؤسسي أنّ مسار الازدهار يمرّ عبر توسيع قاعدة الحقوق الاقتصادية والسياسية، وحماية الملكية، وتمكين ريادة الأعمال، وتثبيت حكم القانون. إنّ إصلاحاتٍ تشريعية وقضائية تُعزّز استقلال القضاء وشفافية الموازنة تشكّل رافعةً أساسيةً لأيّ استراتيجية نهضوية.
ب) تنويع القاعدة الإنتاجية: تجربةُ القطن تُبرز أهمية التحرر من أحادية الصادرات عبر تصنيعٍ موجّه للتصدير، واستثماراتٍ في سلاسل القيمة، وبرامج دعمٍ للابتكار الزراعي والصناعي. يمكن لسياساتٍ صناعية ذكية - ترتبط بالمزايا النسبية المتحوِّلة لا الثابتة - أن تُعيد تموضع الاقتصادات من موردٍ أولي إلى مُنتِجٍ للمعرفة.
ج) نهضةُ التعليم واللغة: تعميم التعليم الجيد وربطه بالبحث والاقتصاد المعرفي، مع تمكين العربية واللغات المحلية في العلوم، وتوسيع جسور الترجمة والتأليف المشترك، يخلق قاعدةً بشريةً قادرة على الابتكار. تبيّن مسارات الجزائر بعد الاستقلال كيف يقود الاستثمارُ المستمر في محو الأمية والتعليم العالي إلى قفزاتٍ ملحوظة في معدّلات الإلمام بالقراءة والكتابة خلال عقود.
د) تكاملٌ إقليمي ذكي: إعادة هندسة التعاون العربي - الإسلامي حول سلاسل الإمداد والطاقة والغذاء والبيانات يخفّف كلفة الحدود الموروثة ويخلق سوقًا أوسع للتصنيع والخدمات التكنولوجية، مع اتفاقيات معايير وتراخيصٍ مشتركة تتجاوز فراغ الحقبة الانتدابية. تُفيد دروسُ المئة عام الماضية أنّ القدرة على صياغة ترتيباتٍ واقعية داخل الإقليم تمنح الدول هامش مناورةٍ أفضل في النظام الدولي.
هـ) سرديةٌ وطنية مندمجة: إعادة تركيب الهوية السياسية على قاعدة المواطنة والعدالة والحرية والرحمة تُؤسّس لعقدٍ اجتماعي يستوعب التعدّد المذهبي والإثني واللغوي ويحوّله إلى طاقةٍ إنتاجية. تنجح مشاريعُ النهضة حين تتقدّم القيمُ الضامنة للكرامة مع مؤسساتٍ تخطيطيةٍ واقتصاديةٍ فعّالة.
رسالة عملية
يكشف تاريخ الاستعمار في العالم الإسلامي أثرًا مركَّبًا: اقتصادٌ مُقنّن للاستخراج، وحدودٌ صنعت هشاشة الدولة الوطنية، وتعليمٌ تعرّض للتجريف، ومؤسساتٌ وُضعت لإدارة التبعية. وتُظهر خبراتُ النصف الثاني من القرن العشرين أنّ بناء الدولة بعد الاستقلال يحقق مكاسب تعلّمٍ وصحةٍ وبنيةٍ تحتية، غير أنّ سدّ الفجوات يتطلّب انتقالًا مؤسسيًا واعيًا نحو الشمول، وتنويعًا إنتاجيًا جادًا، ونهضةً معرفيةً ولغويةً تُقيم صلةً وثيقة بين الجامعة والسوق والمجتمع. يحمل هذا كله رسالةً عملية: مشروعُ النهضة يتغذّى من قراءةٍ دقيقةٍ للإرث الاستعماري، ثم ترجمة الدروس إلى سياساتٍ قابلةٍ للقياس، تُعيد تشكيل الحوكمة والاقتصاد والتعليم ضمن رؤيةٍ متكاملة تتحرك بخطواتٍ تراكمية وتخطيطٍ طويل الأمد.
يكشف تاريخ الاستعمار في العالم الإسلامي أثرًا مركَّبًا: اقتصادٌ مُقنّن للاستخراج، وحدودٌ صنعت هشاشة الدولة الوطنية، وتعليمٌ تعرّض للتجريف، ومؤسساتٌ وُضعت لإدارة التبعية. وتُظهر خبراتُ النصف الثاني من القرن العشرين أنّ بناء الدولة بعد الاستقلال يحقق مكاسب تعلّمٍ وصحةٍ وبنيةٍ تحتية، غير أنّ سدّ الفجوات يتطلّب انتقالًا مؤسسيًا واعيًا نحو الشمول، وتنويعًا إنتاجيًا جادًا، ونهضةً معرفيةً ولغويةً تُقيم صلةً وثيقة بين الجامعة والسوق والمجتمع. يحمل هذا كله رسالةً عملية: مشروعُ النهضة يتغذّى من قراءةٍ دقيقةٍ للإرث الاستعماري، ثم ترجمة الدروس إلى سياساتٍ قابلةٍ للقياس، تُعيد تشكيل الحوكمة والاقتصاد والتعليم ضمن رؤيةٍ متكاملة تتحرك بخطواتٍ تراكمية وتخطيطٍ طويل الأمد.