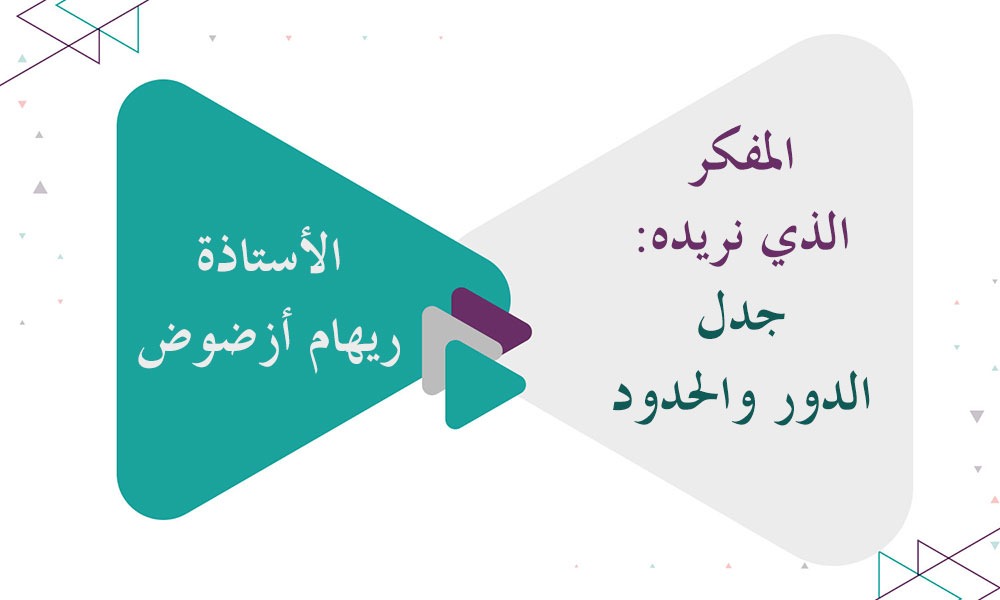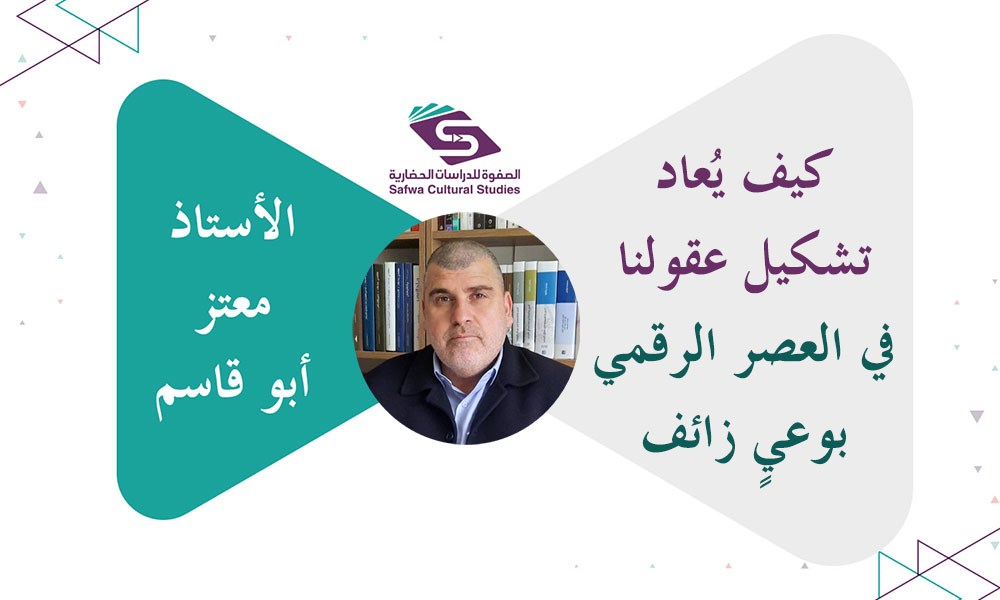مدخل عام
عند دراسة الحضارات، ينبغي إدراك أنَّ الكمال غير موجود؛ فكل حضارة تحمل بذور ضعفها في داخلها، وهي في حالة مدّ وجزر: صعود وتطوّر، ثم تآكل وانهيار، ليأتي بعدها طور جديد. هذه القاعدة هي ما يسميه القرآن الكريم: ﴿ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾. كما أن الحضارات لا تنهض في جميع مساراتها دفعة واحدة؛ فقد تبلغ الذروة في الفلسفة، بينما تكون ضعيفة في الأخلاق أو السياسة أو العسكر. ثم إن عوامل التآكل الحضاري لا تحدث بضربة قاضية، بل تتشكَّل عبر أزمنة طويلة حتى تُسقط الأمة.
الحضارة الإسلامية بدورها عاشت هذا المنطق. فقد وُلِدَت في لحظة ضعف الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية، وامتصَّت من منجزاتهما الفكرية والإدارية والفلسفية، وصهرت ذلك في بوتقة واحدة، فكان لها إطارها الخاص الذي ميَّزها. لكنَّها، مثل غيرها من الحضارات، لم تكن في معزل عن التفاعل مع الآخر، بل كانت ترى نفسها دومًا في مرآة الغرب منذ الحروب الصليبية وحتى اليوم.
أولاً: الخط العلمي
نشأ الخط العلمي الإسلامي من الحاجة الدينية والمعرفية، فانبثقت علوم التفسير والحديث والفقه وأصوله، إلى جانب علوم التصوُّف والسلوك. ومع توسُّع المسلمين نحو حضارات أخرى، دخلت الفلسفة اليونانية والمنطق، واستفادوا من النظم الإدارية الفارسية.
في تلك المرحلة، كانت الفلسفة تشمل الطب والعلوم التطبيقية، لذا برز أعلام كابن سينا والفارابي باعتبارهم فلاسفة وأطباء في آن واحد. حملت هذه العلوم قضايا الفلسفة الكبرى التي طرحها أفلاطون وأرسطو، مثل: «الميتافيزيقيا»، و«نظرية المعرفة»، و«الأخلاق»، و«السياسة». غير أن المسلمين سعوا إلى مواءمة الفلسفة مع مقاصد الشريعة، لإنتاج عقلانية إسلامية.
لكن هذا المسار وصل إلى جمود ابتداءً من التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي، حيث ساد التكرار والشرح دون ابتكار. فتوقف التجديد، وتحوَّل العِلم إلى اجترار لما سبق، مما انعكس على الفضاء الديني والعلمي معًا. لذلك، عندما جاء نابليون إلى مصر، وجد بيئة معرفية متآكلة لم تواكب عصرها.
ثانياً: الخط العسكري
بدأ الخط العسكري الإسلامي بالفتوحات، فحقق توسُّعًا لافتًا. لكنه سرعان ما توقَّف ليدخل مرحلة تراجع طويلة. فمع القرن السادس عشر، انهزمت الدولة العثمانية في البحر والبر، وتآكلت أراضيها، وضعفت قدرتها على حماية بلاد المسلمين. هذا الانهيار أفرغ الحياة العسكرية في الأطراف، وتركت المجتمعات تنتظر "المنقذ التركي" بينما كانت الإمبراطورية قد فقدت تأثيرها.
ثالثاً: الخط السياسي
منذ اللحظة الأولى، عانى الفعل السياسي الإسلامي من الاضطراب. فعندما استقر، استقر على قاعدة حكم المتغلِّب دون محاسبة أو آليات عزل أو تداول سلمي للسلطة. ومع ضعف الخلافة العباسية، تفتَّتَت الدولة إلى دويلات متناحرة.
هذا الانهيار السياسي انعكس على المجتمع؛ إذ انقسم إلى طبقةٍ مُترَفَةٍ مستفيدةٍ من الحكم، وطبقةِ فقهاء معزولة عن قضايا المجتمع الكبرى، وطبقةٍ شعبيةٍ مسحوقةٍ تعيش البؤس. حتى في أزهى عصور الخلافة العباسية، كان القاع الاجتماعي يعاني غياب العدالة، كما أشار أبو يوسف في "كتاب الخِرَاج"، حيث وثَّق مظالم السجون والمعاملة القاسية للمسجونين.
رابعاً: المسار الاجتماعي
رغم الاضطرابات السياسية، شهد المجتمع الإسلامي بعض المزايا النسبية مقارنةً بالغرب في العصور الوسطى. فقد حظيت المرأة بحقوق التعلُّم والتملُّك ولو بشكل نظري، في حين كانت محرومة من ذلك في أوروبا حتى القرن العشرين. كما نال أهل الذمة وضعًا قانونيًا أفضل نسبيًا مما كان عليه حال الأقليات في الأمم الأخرى.
لكن هذا التفوُّق لم يستمر، إذ توقف التجديد الاجتماعي والثقافي منذ القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي. وتعمَّقت الأزمات مع قضايا مثل الرِّق والسَّبِي، حيث تعامل الفقهاء مع أعراف سابقة على الإسلام وأضفوا عليها الشرعية، رغم أن القرآن كان يتَّجِه إلى التحرير. هذه التناقضات بين مقاصد النصّ القرآني والاجتهادات الفقهية أنتجت أزمات فكرية وأخلاقية عميقة، لا تزال مثار جدل حتى اليوم.
خاتمة
تكشف قراءة الحضارة الإسلامية في خطوطها المتعدِّدة؛ العلمي، العسكري، السياسي، والاجتماعي، أنها لم تنهض دفعة واحدة، ولم تسقط دفعة واحدة. بل كانت تسير بـ «منطق التداول الحضاري»، فتتفوَّق أحيانًا على الأمم الأخرى، ثم تتراجع أمامها في أحيان أخرى. إلا أن الجمود الذي أصاب العقل الفقهي والعلمي، والانهيار السياسي والعسكري، وانسداد آفاق التجديد الاجتماعي، شكّلت كلها عوامل أساسية في الانحسار الحضاري.
* * *