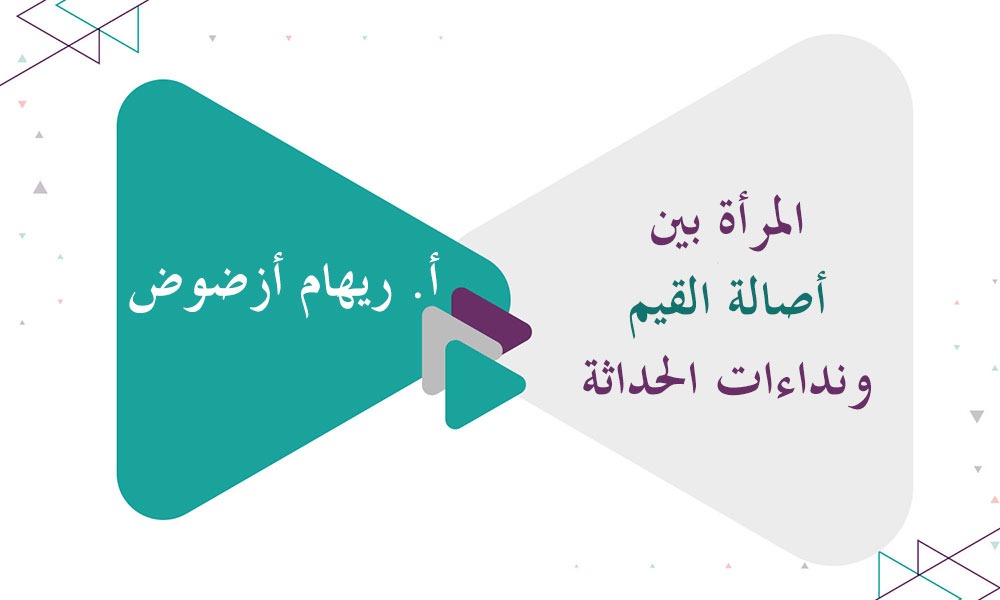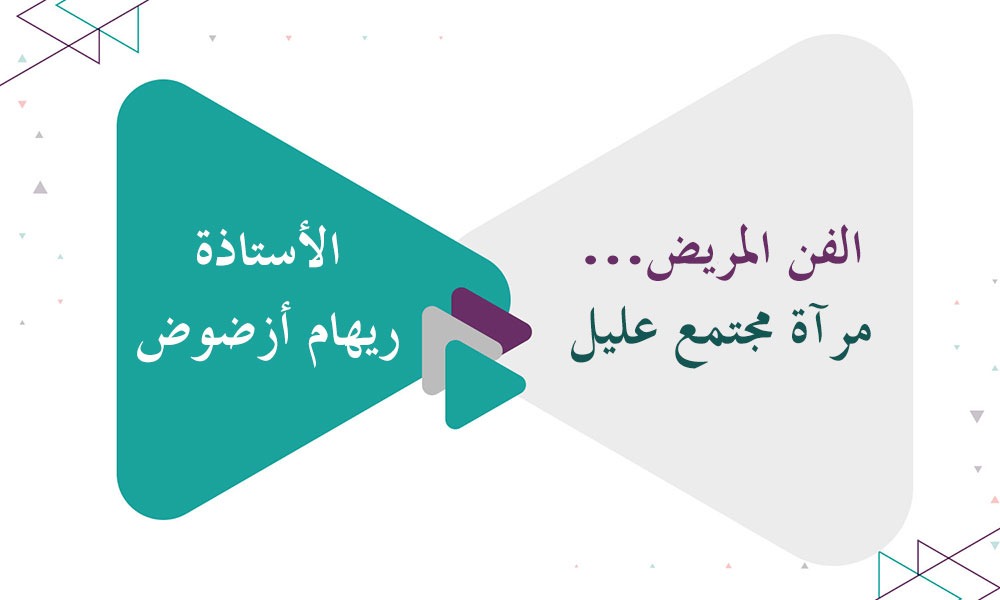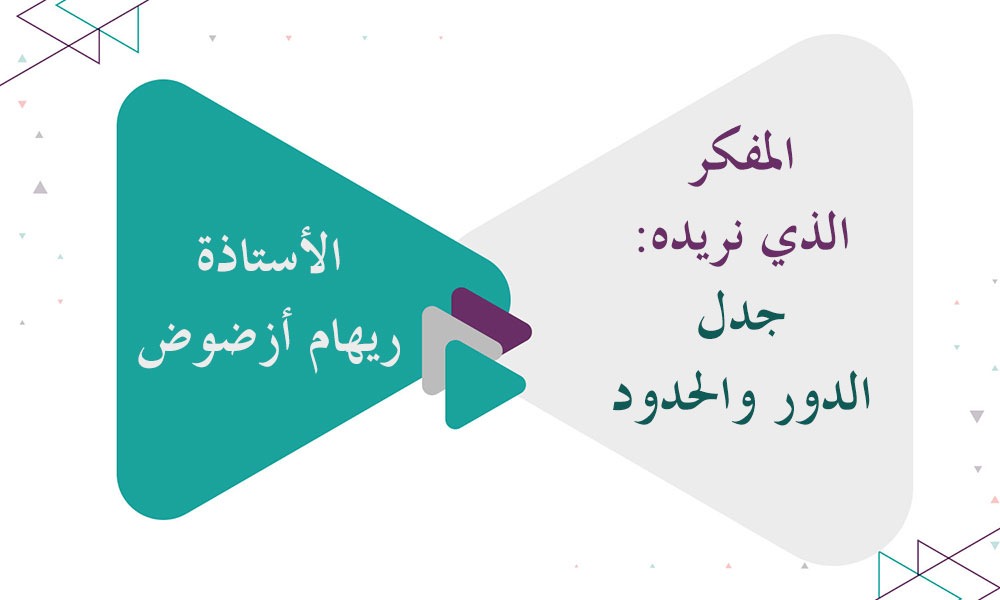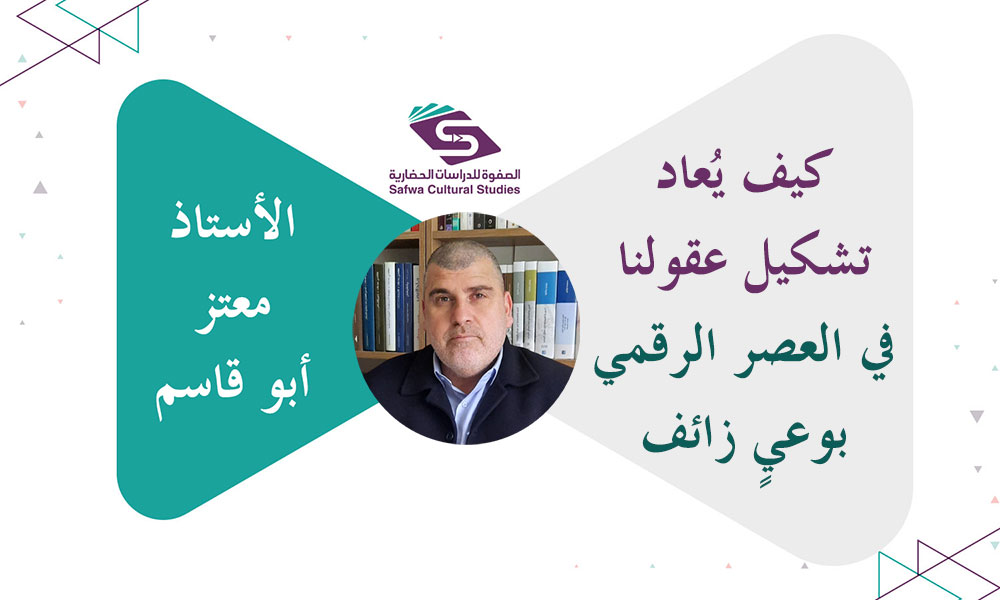منذ قرنين والعقل المسلم يطرح السؤال ذاته بصيغٍ متجددة:
ماذا نأخذ من الغرب وماذا نترك؟
هل نرفض كل ما أنتجه؟ أم نأخذ ما لا يتعارض مع تراثنا؟ أم نتبنّى رؤية ثالثة تُعيد ترتيب العلاقة على أسسٍ أكثر وعيًا واتزانًا؟
هل نرفض كل ما أنتجه؟ أم نأخذ ما لا يتعارض مع تراثنا؟ أم نتبنّى رؤية ثالثة تُعيد ترتيب العلاقة على أسسٍ أكثر وعيًا واتزانًا؟
إنه سؤالٌ قديم متجدّد، لم يغب يومًا عن خطاب النهضة، لكنّ جوهره تغيّر؛ فبينما كان سؤال الأمس فكريًا نظريًا، صار اليوم سؤال بقاء وفاعلية.
من سجال الهوية إلى مأزق الفاعلية
اعتدنا عند كل قضيةٍ أن نبدأ بنقاش المشروعية والهوية: هل يجوز أن نستفيد من الآخر؟ هل نملك ما يغنينا عنه؟
لكنّ هذا النمط من النقاش - الذي ظنناه حارسًا للهوية - تحوّل مع الوقت إلى حاجزٍ نفسيٍّ يمنعنا من التعلم والفعل.
لكنّ هذا النمط من النقاش - الذي ظنناه حارسًا للهوية - تحوّل مع الوقت إلى حاجزٍ نفسيٍّ يمنعنا من التعلم والفعل.
جيل اليوم يعيش الواقع الغربي بكل تفاصيله التقنية والمعرفية؛ يدرس بلغاته، ويتخصّص في جامعاته، ويعمل ضمن أنظمته… دون أن يحمل عقدة المشروعية التي أثقلت أجيالاً قبلَه.
إنه جيلٌ دخل العصر من أبوابه الرقمية والعملية، بينما ما زال بعضنا يناقش في مجموعات واتساب حدود “الهوية” و“الخصوصية” دون بناء أدواتٍ عمليةٍ تحفظ تلك الهوية فعلاً لا قولاً.
إنه جيلٌ دخل العصر من أبوابه الرقمية والعملية، بينما ما زال بعضنا يناقش في مجموعات واتساب حدود “الهوية” و“الخصوصية” دون بناء أدواتٍ عمليةٍ تحفظ تلك الهوية فعلاً لا قولاً.
ما بين الرفض الأجوف والوعي البنّاء
قال الشيخ محمد الغزالي يومًا: "لو أخرجنا من حياتنا كل ما هو غربي، لاضطررنا أن نسكن الخيام".
وهذه المقولة تختصر حالنا اليوم: نستنكر الغرب بلساننا، ونعيش على منجزاته بأيدينا.
نلبس لباسه، ونتغذّى بطعامه، ونتعامل بأدواته، ثم نقول: نحن الأفضل لأننا نملك “الاستقامة”!
الخطأ لا في الاستفادة من منجزات الآخرين، بل في الجمود عند حدود الاستهلاك دون الانتقال إلى الإنتاج.
وهذه المقولة تختصر حالنا اليوم: نستنكر الغرب بلساننا، ونعيش على منجزاته بأيدينا.
نلبس لباسه، ونتغذّى بطعامه، ونتعامل بأدواته، ثم نقول: نحن الأفضل لأننا نملك “الاستقامة”!
الخطأ لا في الاستفادة من منجزات الآخرين، بل في الجمود عند حدود الاستهلاك دون الانتقال إلى الإنتاج.
المطلوب أن ندرس الغرب كظاهرة حضارية لا كمصدر تهديد: أن نفهم كيف بَنَى مؤسساته، وكيف صاغ فلسفته، وكيف نقل فكره إلى واقع.
وعندها فقط نقدر أن نبدأ من جديد… لا بالتكرار، بل بالاستيعاب والتحويل.
وعندها فقط نقدر أن نبدأ من جديد… لا بالتكرار، بل بالاستيعاب والتحويل.
مرجعية الوحي وبناء المنهج العلمي
يميل البعض إلى الظنّ أن امتلاكنا للكتاب والسنة يغنينا عن بناء العلوم والنظم. لكنّ القرآن لم يُنزَل ليكون كتاب تلاوة فقط، بل كتاب اكتشافٍ وعملٍ وبناء.
لقد منحنا الوحي القيم الكبرى، ثم وجّهنا إلى “النظر في الآفاق والأنفس” لاكتشاف القوانين وتسخيرها في بناء الحضارة.
إلا أننا، في أغلب مساراتنا الفكرية، توقّفنا عند حدود النص ولم نعبر إلى فضاء الفعل، فظلّ الفراغ العلمي والعملي بين الوحي والواقع يتّسع يومًا بعد يوم.
لقد منحنا الوحي القيم الكبرى، ثم وجّهنا إلى “النظر في الآفاق والأنفس” لاكتشاف القوانين وتسخيرها في بناء الحضارة.
إلا أننا، في أغلب مساراتنا الفكرية، توقّفنا عند حدود النص ولم نعبر إلى فضاء الفعل، فظلّ الفراغ العلمي والعملي بين الوحي والواقع يتّسع يومًا بعد يوم.
من التنظير إلى المختبر
حين نقرأ إنتاجنا في مجالات الاقتصاد أو التربية أو السياسة، نجد أنه يبدأ بنصوصٍ شرعية ومقدماتٍ فكرية جميلة، ثم ينتهي بتطبيقاتٍ مستوردة من الغرب!
نملك المبادئ، لكننا نفتقر إلى الأدوات والمؤسسات التي تختبر وتُجسّد تلك المبادئ. فلا مختبرات للأفكار، ولا نظريات قابلة للقياس، ولا مناهج تتيح لنا التحوّل من “القول” إلى “التمكين”.
نملك المبادئ، لكننا نفتقر إلى الأدوات والمؤسسات التي تختبر وتُجسّد تلك المبادئ. فلا مختبرات للأفكار، ولا نظريات قابلة للقياس، ولا مناهج تتيح لنا التحوّل من “القول” إلى “التمكين”.
إن الفرق بيننا وبين الغرب ليس في الإيمان أو القيم، بل في التحويل المؤسسي للفكر إلى واقع.
لقد أنتج الغرب أدواته ومعاييره، وصار مرجعًا عالميًا في تخصصاته، بينما بقينا في موقع المتلقي والناقد دون أن نُقدّم البديل الفاعل.
لقد أنتج الغرب أدواته ومعاييره، وصار مرجعًا عالميًا في تخصصاته، بينما بقينا في موقع المتلقي والناقد دون أن نُقدّم البديل الفاعل.
نحو تجاوز عقدة الرفض والتبعية
ليس المطلوب أن نغرق في جلد الذات، ولا أن نذوب في الآخر، بل أن نؤسس مسارًا ثالثًا يقوم على الاستيعاب الواعي والتجريب الجاد.
نختبر ما عند الآخرين، ونستفيد منه، ثم نعيد صياغته ضمن قيمنا القرآنية والإنسانية، ليولد منه فكرٌ ونهجٌ جديد يُعبّر عنّا.
نختبر ما عند الآخرين، ونستفيد منه، ثم نعيد صياغته ضمن قيمنا القرآنية والإنسانية، ليولد منه فكرٌ ونهجٌ جديد يُعبّر عنّا.
النهضة ليست شعارًا نعلّقه، بل منظومةُ وعيٍ ومؤسساتٍ وأدوات. وما لم ننتقل من النقاش النظري إلى البناء العملي، سنبقى في موقع المفعول به، لا الفاعل.
من الوعي إلى الشهود الحضاري
حين نملك القدرة على إنتاج المعرفة، وصياغة المعايير، وبناء المؤسسات على قيمنا، عندها فقط يمكن أن نقول: نحن أمة فاعلة في التاريخ.
أما اليوم، فالمطلوب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، لا من حيث بدأوا، وأن نُعيد وصل الوحي بالعقل، والفكر بالفعل، لنستعيد شهودنا الحضاري من جديد.
أما اليوم، فالمطلوب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، لا من حيث بدأوا، وأن نُعيد وصل الوحي بالعقل، والفكر بالفعل، لنستعيد شهودنا الحضاري من جديد.
منظومةٌ قِيَميّة (عَدْل، إحسان، رحمة)، مع رابطٍ إيمانيٍّ واحتياجٍ لا نستطيع توفيره ذاتيًّا، هي مدخلاتُ تعاملنا مع العالم. ثم تأتي عمليةُ انتقاءِ الحكمة من أيِّ مجتمعٍ بشريٍّ وفق تلك المسطرة، فاختبارُ هذا المنتجِ المُفلتر في بيئتنا، ثم تعديلُه بما يُلائمُنا. هكذا تَجري دورةُ الرُّشد؛ فبالمسطرةِ نصونُ الهوية، وبالانتقاءِ العاقل نبدأُ من حيثُ انتهى الناس.