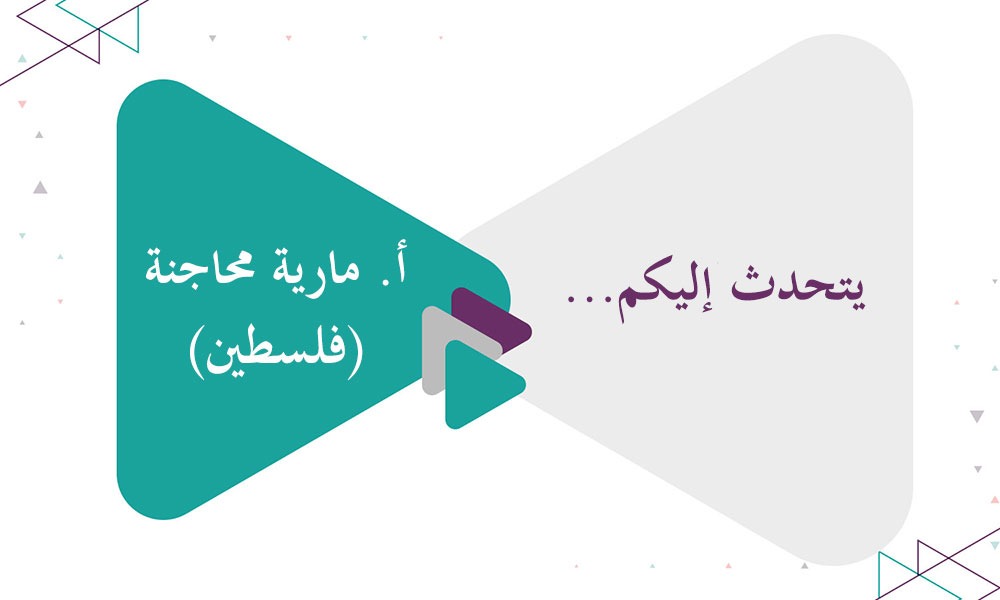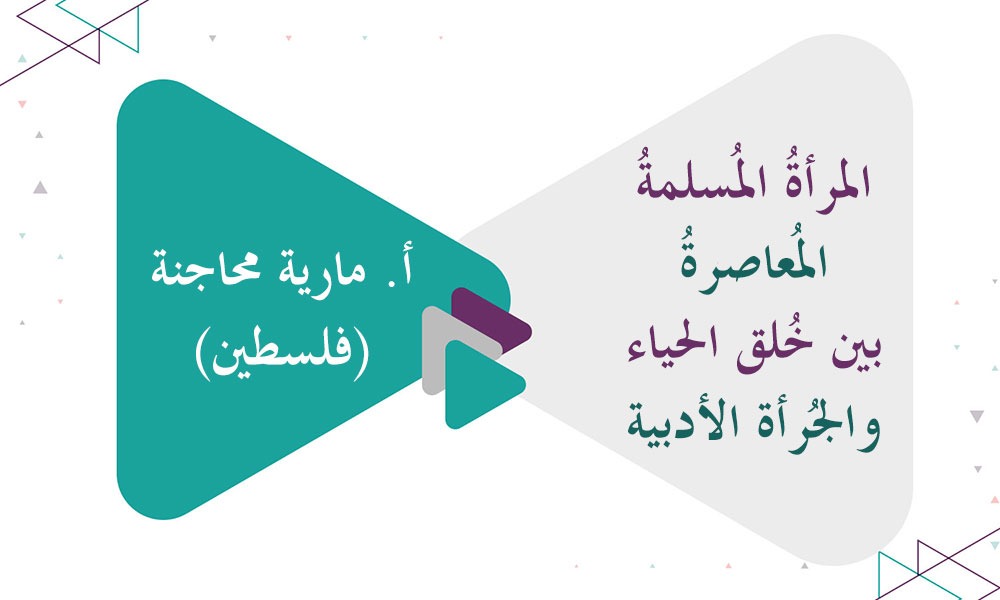بادئ ذي بدء إن المعرفة ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق غايات أسمى. وهذا يقودنا إلى إدراك الوظيفة الحقيقية للتعلم في حياة الإنسان والمجتمع، والمعرفة هي الأداة التي يفهم بها الإنسان ذاته والعالم من حوله، وهي المفتاح الذي يحل به مشكلاته، ويواجه به تحدياته، وهي السلاح الذي يدافع بها عن كرامته ويحقق به نهضة أمته (ابن خلدون، 1377هـ).
إن التربية الهادفة لا تنتج أفرادًا بلا بوصلة أو غاية، بل تُنشئ إنسانًا يدرك رسالته في الحياة، سواء كانت رسالة عمران الأرض والبناء الحضاري، أو رسالة إنسانية، أو رسالة أخلاقية لصالح مجتمعه والانسان الذي يدرك رسالته في الحياة هو انسان ذو معنى وهدف وهذا ما يمنحه الدافعية الحقيقية للتعلم والعطاء المستمر. والحياة الانسانية عند أبي حامد الغزالي على سبيل المثال هي رحلة معرفية ترتكز على تجاوز حدود الحواس للوصول الى المعنى الأعمق للوجود، والذي يتمثل في الحب لمطلق لله تعالى (نظرية المعرفة عند أبي حامد الغزالي).
ان النظام التربوي الفاعل هو ذلك الذي يجيب بوضوح عن سؤال، أي انسان نريد، ولماذا؟ ولأي عصر ورسالة؟ وهو الذي يُدرك الغاية العليا للمعرفة ويربطها باحتياجات الفرد والمجتمع. وهو الذي يمتلك منهجية علمية لإنتاج معرفة فاعلة عميقة ومتجذرة ومرتبطة بالقيم. وهو الذي يُوظف أفضل الطرائق والأساليب والتقنيات لتفعيل هذه المعرفة وتحويلها إلى واقع معاش. وهو أخيرًا الذي يمتلك أدوات تقويم دقيقة وشاملة تتأكد من تحقق الأثر وتستخدم النتائج في التحسين المستمر (Hattie, 2009).
ولا شك أن إدراك الإنسان لأهمية المعرفة ورسالتها يُحدث فرقًا جوهريًا في دافعيته للتعلم ومثابرته في طلب العلم فالطالب الذي يُدرك أن ما يتعلمه سيمكنه من خدمة دينه ووطنه وأمته، وأنه سيكون أداة للتغيير والإصلاح، هو طالب مختلف تمامًا عن ذلك الذي ينظر إلى التعليم كواجب ثقيل أو طويل للحصول على وظيفة فحسب.
وجدير بالذكر أن التربية الفاعلة هي تلك التي تُكسب المتعلم القدرة على التعامل الذكي مع هذه المصادر المتنوعة، والتمييز بين المصطلحات وبناء معرفته الخاصة بطريقة نقدية وواعية (Paul & Elder, 2006).
فإن الاهتمام بالمهارات المعرفية العليا التي تحول المعلومات إلى معرفة فاعلة أمر ضروري، هذه المهارات تشمل لتفكير الناقد الذي يمكّن المتعلم من تحليل المعلومات وتقييمها، والتفكير الإبداعي الذي يولد أفكارًا وحلولًا مبتكرة، والتفكير المنظومي الذي يرى الترابطات والعلاقات بين الظواهر المختلفة ومهارات حل المشكلات واتخاذ القرار التي تُطبق المعرفة في مواقف حقيقية (Anderson & Krathwohl, 2001؛ Senge, 1990).
ومن هذا المنطلق لابد من التأكيد على أهمية البعد القيمي والأخلاقي في إنتاج المعرفة. فالمعرفة المجردة من القيم يمكن أن تكون خطيرة ومدمرة. والتاريخ مليء بأمثلة لمعارف استُخدمت لأغراض غير أخلاقية لأنها افتقدت البوصلة القيمية (Postman, 1992).
لذا فإن التربية الفاعلة تربط المعرفة بالقيم، وتُنشئ متعلمين يدركون المسؤولية الأخلاقية المترتبة على ما يعملون (Lickona, 1991،2005 ، الاطرش).
وعلى المستوى العملي لا بد أن نُولي اهتمامًا خاصًا لمهارات التعلم الذاتي المستمر. في عالم سريع التغير، فلم تعد المعرفة التي يكتسبها الإنسان في سنوات دراسته كافية لمواجهة تحديات الحياة. والتربية الفاعلة هي تلك التي تُعلّم المتعلم كيف يتعلم، وتزوده بالأدوات والمهارات التي تمكنه من تجديد معارفه وتطوير كفاياته باستمرار (Knowles, 1975؛ Zimmerman, 2002).
وحري بنا التطرق الى وظيفة التربية عند مالك بن نبي، الذي يرى أن وظيفتها هي صناعة الانسان المتحضر، فهي عملية مستمرة تهدف الى بناء شخصية الانسان المسلم وتشكيلها ليكون قادرا على قيادة نهضة الأمة، وتغيير واقعها نحو الأفضل، وذلك من خلال ربط الانسان بالمبادئ الأربعة: الأخلاق، والجمال، والمنطق العملي، والعلم والصناعة، فالتربية عند مالك بن نبي ليست مجرد تلقين للمعلومات، بل هي عملية بناء شاملة للإنسان، وتتجاوزها الى بناء المجتمع، والأمة بأكملها (بن نبي،2006).
إن مشكلتنا هي مشكلة مناهج بالدرجة الأولى، فالتربية الفاعلة هي التي تقدم للمتعلم تجارب حقيقية. فالمعرفة الحقيقية ليست تلك المخزونة في الأذهان فحسب، بل تلك المُفعّلة في الواقع والمُطبّقة في الحياة. والسؤال عن كيفية التفعيل يقودنا إلى الحديث عن المنهجية التربوية والأساليب والطرائق التي (Kolb, 1984) تُقدم من خلالها المعرفة ويتعلق الأمر بالمناهج بمفهومه الشامل. والمنهج الفاعل ليس مجرد محتوى معرفي يُدرّس، بل هو منظومة متكاملة تشمل الأهداف والمحتوى وطرائق التدريس والأنشطة ووسائل التقويم. هذا المنهج ينبغي أن يكون متوازنًا بين الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية، ومرنًا بما يكفي ليستجيب لاحتياجات المتعلمين المتنوعة وخصائصهم الفردية (Tomlinson, 2001).
وتبرز أهمية طرائق التدريس الحديثة التي تحول المتعلم من متلقٍ سلبي إلى مشارك نشط في بناء معرفته. هذه الطرائق تشمل التعلم النشط الذي يشرك المتعلم في أنشطة حقيقية تتطلب التفكير والتحليل (Bonwell & Eison, 1991) والابداع، والتعلم التعاوني الذي ينمي مهارات العمل الجماعي والتواصل (Johnson & Johnson, 1999)، والتعلم القائم على حل المشكلات الذي يضع المتعلم أمام مواقف حقيقية تتطلب حلولًا(Barrows & Tamblyn, 1980)، والتعلم بالمشاريع الذي يُنتج منتجات ملموسة تربط المعرفة بالواقع (Krajcik & Blumenfeld, 2006).
والتقنية ليست غاية في حد ذاتها، ولكنها أداة قوية عندما تُوظف بذكاء في العملية التربوية، فالمنصات الرقمية، والبرمجيات التعليمية، والواقع الافتراضي والمعزز، والذكاء الاصطناعي كلها أدوات يمكن أن تُثري التجربة التعليمية، وتجعل المعرفة أكثر حيوية وتفاعلية وقابلة للتطبيق (Mishra & Koehler, 2006؛ Selwyn, 2016).
وتأسيسا على ذلك فإن النظم التربوية المعاصرة تواجه تحديات متزايدة تتعلق بقدرتها على إنتاج معرفة فاعلة وتوليد المعنى في عالم سريع التغير، فلم تعد المؤسسات التعليمية معنيةً بنقل المعلومات فحسب، بل أصبحت مطالبةً بإنتاج معرفة جديدة متجذّرة في الواقع الإنساني والاجتماعي. فالمعرفة التي تُقدَّم دون معنى تتحول إلى عملية ميكانيكية فاقدة للحياة، بينما يشكّل توليد المعنى جوهر الفعل التربوي ذاته، إذ يمنح التعلم بعده الإنساني والوجودي (عبد السلام، 2021).
وتمثل فاعلية النظام التربوي محصلة تكاملية لمنظومة من العناصر المترابطة التي تبدأ بوضوح الرؤية الفلسفية، أو الغاية التي يراد الوصول اليها، وتنتهي بدقة التقويم والمتابعة المستمرة. ولا يمكن لأي نظام تربوي أن يحقق أهدافه المنشودة دون الإجابة الواعية والعميقة عن الأسئلة الجوهرية التي تشكل البوصلة الموجهة لكل عملية تربوية (Tyler, 1949).
وهذه الأسئلة ليست مجرد استفسارات نظرية ولا ترف فكري، بل هي محاور أساسية تحدد هوية المنتج التربوي وجودته وأثره في المجتمع والحضارة، وتعكس الفلسفة التربوية التي توجه العملية التعليمية (Dewey, 1938) كلها.
لكن يبقى التساؤل مطروحا لماذا نقول إننا نسعى الى النهضة بينما مناهجنا التعليمية مازالت غربية؟
إن جعل القران الكريم مركز المناهج ليس مجرد اضافة معرفية، بل هو تأسيس لرؤية تربوية متكاملة للإنسان وبناء للمعنى، فالقران الكريم يقدم نسقا معرفيا وقيميا متكامل يربط العلم بالإيمان والعمل (الطهطاوي،2019).
وتوظيف المنهج القرآني في التفكير في المناهج التربوية والتعليمية يعني تدريب المتعلمين على التدبر والتأمل، والاستنباط، وهي عمليات عقلية عليا تحوّل التعلم من التلقين الى الفهم النقدي الواعي (ابن عاشور، 1984).
وتكامل المناهج حول مفاهيم قرآنية مركزية مثل الاستخلاف، الأمانة، العدل والعمران يجعل القيم خيطا ناظما لكل مجالات المعرفة (القرني،2018).
ومن هذا المنطلق فان فاعلية التربية تظهر في قوة التغيير النوعي الذي تحدثه في فكر الانسان، قناعاته، سلوكه، وقدراته على مستوى التكيف والابداع، وليست الفاعلية في حجم المعلومات، بل في عمق الفهم، ودوام الأثر، وفي تعليم وتدريب المتعلم على مهارات القرن الحادي والعشرين، التي تبقى لمدى الحياة. والأهداف التربوية انما تصوغ قيما عقدية، فكرية، أخلاقية واجتماعية. وتساهم في بناء هوية المتعلم وأسلوبه في الحياة. فالتربية الفاعلة تنتج المعرفة التي تولّد المعنى.
ومن زاوية أخرى فان المعنى هو البعد الجوهري الذي يمنح المعرفة قيمتها وغرضها. فحينما ينفصل التعلم عن المعنى يفقد قدرته على الإلهام والتحفيز. ويتحقق إنتاج المعنى عندما يشعر المتعلم أن ما يتعلمه يرتبط مباشرة بحياته وهويته وقيمه، وأن المعرفة تُمكّنه من إحداث فرق في واقعه الاجتماعي (van Manen, 1990).
أما غياب المعنى فيؤدي إلى ضعف إنتاج المعرفة، إذ يفقد المتعلم الدافع للبحث والتجريب، فتتحول العملية التعليمية إلى أداء شكلي بلا هدف (عبد السلام، 2021). وهذا بالضبط ما يعانيه كثير من شبابنا اليوم حيث يفقد أغلبهم الرغبة في مواصلة الدراسة، والشغف في البحث العلمي، في غياب البعد الحضاري للمناهج، وبأهداف تعليمية لا تلبي في الغالب حاجاته العقلية، النفسية، الاجتماعية، الروحية والوجدانية، ولا تراعي بصفة عامة خصائص نموه، ولا خصائص تعلمه. فالمتعلم بحاجة الى انتاج المعنى قبل الشروع في التعلم، وانتاج المعنى هو أن يفهم المتعلم العالم الطبيعي المحيط به وعالمه الاجتماعي الذي يعيش فيه، ويفهم ذاته، ضمن سياق شامل يتمحور حوله مغزى وجوده في هذه الحياة، أي أن يجيب المتعلم عن سؤال لماذا أتعلم. وهذا يعني أن يتجاوز مجرد الفهم الى التأويل ثم الى الابداع.
والتربية المنتجة للمعنى هي التي لا تقدم المعارف كحقائق جامدة، أو كنتائج غير قابلة للتغيير، بل كنتائج لجهود بشرية مفتوحة للتأويل والنقاش والتحليل. وهي تلك التربية التي تربط المتعلم بالخبرات الشخصية والاجتماعية، بحيث يكون المتعلم ذاته منتجا للمعنى لا مجرد متلق لها، ومن منظور الفيلسوف جون ديوي فإن "المعرفة التي لا تولد معنى في حياة الانسان لا يمكن أن تسمى تربية". ومن هذا المنطلق فان غياب المعنى يؤدي إلى ضعف إنتاج المعرفة، إذ يفقد المتعلم الدافع للبحث والتجريب، فتتحول العملية التعليمية إلى أداء شكلي بلا هدف (عبد السلام، 2021). وهذا بالضبط ما يحصل من فقدان المعنى والشغف للتعلم عند الكثيرين، ولذلك فإن مشاركة المتعلم في بناء المعنى يعني أن يكون هو محور العملية التعليمية بحيث تكون العملية التعليمية عملية تأملية، تحليلية، تناقش وتربط بين الظواهر فهي عملية تأويلية تشاركية تتجاوز ظاهر النص أو المعلومة إلى تأمل دلالاتها وربطها بتجربة الإنسان في العالم، وهذا ما يجعلها عملية تربوية تفاعلية إنسانية بامتياز بين المعلم والمتعلم، (Ricoeur, 1976).
وإنتاج المعرفة التربوية انما يتولد من خلال إنتاج الغرض منها وبالتالي توليد المعنى، فالمعرفة التربوية ليست منظومة جاهزة تُستورد من الخارج لتطبق بحذافيرها كما هي، ولا معلومات تقدم عل أساس أنها مسلمات لا يمكن اعادة النظر فيها، بل هي معرفة تنبع من تجارب المجتمع وخبراته المتميزة، وتُنتج من داخل الممارسة التربوية اليومية بين المعلم والمتعلم. فكل تفاعل تربوي يحمل في طياته معرفة ضمنية يمكن استخراجها بالتأمل والتحليل (Schön, 1983).
ويتم إنتاج المعرفة التربوية الفاعلة من خلال إنتاج المعنى عبر ثلاث خطوات أساسية:
1. تحليل الممارسات التربوية وتأملها نقديًا، إذ تكمن المعرفة في الخبرة العملية ذاتها (Schön, 1983).والتركيز على مهارات التفكير العليا وتنمية مهارة التفكير النقدي وتنمية مهارة التفكير الابداعي، ومهارة حل المشكلات.
2. ربط المعرفة بالحياة، ودمج الفعل بالتفكير، والتركيز على بناء معرفة ذات مغزى تتصل بواقع المتعلم وتجاربه تجعله أكثر تكيفا مع محيطه الطبيعي والاجتماعي، وتحديات العصر مما يجعله يحقق هدفا عمليا واجتماعيا، بحيث تُصبح العملية التعليمية مجالًا لتوليد الفكر من خلال الممارسة (Dewey, 1938).
3. إعادة بناء الخبرة التعليمية في ضوء معناها، أي تحويل التجربة إلى مصدر مستمر لإنتاج المعرفة عبر التأمل والتحليل (Kolb, 1984). وتنمية الكفايات اللازمة للاندماج في مجتمع المعرفة، فهو تعلم لمدى الحياة، مع القدرة على التجديد المستمر في عالم سريع التغير.
وبذلك تُصبح التربية مجالًا لإنتاج المعرفة والمعنى معًا، عبر الحوار الإنساني القائم على المشاركة والتفاعل. بل ان المعنى هو غاية ونتيجة في ان واحد، والطريق الموصل اليها هو التربية الفاعلة.
ومن كل ما سبق يتضح لنا أن العلاقة بين المعرفة والمعنى علاقة تأسيسية لا يمكن الفصل بينها، فالمعرفة التي تُنتج دون معنى تفقد فاعليتها، والمعنى الذي لا يستند إلى معرفة يصبح فارغًا من المضمون. إن النظم التربوية التي تنجح في الجمع بينهما هي تلك التي تضع الإنسان في مركز العملية التعليمية، وتتعامل مع المعرفة بوصفها ممارسة إنسانية تسعى إلى الفهم والتحرر والتجديد (Habermas, 1987). ومن هنا، فإن إنتاج المعرفة التربوية لا يتحقق إلا عبر إنتاج المعنى الإنساني الذي يمنح التعلم هدفه وغايته (عبد السلام، 2021).
إن التحدي الحقيقي الذي يواجه نظمنا التربوية اليوم ليس في نقص الموارد أو الإمكانات فحسب، بل في غياب الرؤية الواضحة والإرادة الحقيقية للإصلاح الجذري. انها أزمة انتاج المعنى، ونحن بحاجة إلى ثورة تربوية حقيقية تبدأ من الأسئلة الفكرية الكبرى وتنتهي بممارسات يومية تُحدث فرقًا في حياة (Wagner, 2008) المتعلمين والمجتمع.
نحن بحاجة إلى تربية تُخرج إنسانًا صالحًا ومصلحًا، عالمًا وعاملاً، مبدعًا ومنتجًا، متمسكًا بأصالته ومنفتحًا على عصره، يحمل رسالة الخلافة والعمران، ويسعى لتحقيق ذلك بكل إخلاص وإتقان. وخلاصة القول ان فاعلية النظم التربوية تُقاس بمقدار ما تُحدثه من تغيير ايجابي نحو الأفضل في نفوس وعقول المتعلمين، وبمدى مساهمتهم في بناء حضارة إنسانية قائمة على العلم، والعدل، والخير، والجمال. هذا هو المعيار الحقيقي للنجاح والفلاح وهذه هي الغاية التي ينبغي أن نسعى إليها جميعًا. ولا يكون ذلك إلا إذا أعدنا للقران الكريم مركزيته في المناهج التربوية والتعليمية، وجعلنا الإنسان محور التغيير المنشود.
قائمة المراجع العربية
-
ابن عاشور، محمد الطاهر. (1984).التحريروالتنوير. تونس: الدارالتونسية للنشر.
-
الطهطاوي، عبد الرحمان. (2019). فلسفة التربية القرانية: نحونموذج تكاملي للمعرفة والقيم. القاهرة: دار السلام
-
القرني، عبد الله. (2018). التكامل المعرفي في ضوء القران الكريم: رؤية تربوية. الرياض: جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية.
-
بن نبي، مالك. (2006). شروط النهضة. دار الفكر.
-
عبد السلام، أحمد. (2021). التربية والمعنى: نحو فلسفة تربوية إنسانية. القاهرة: دار الفكر العربي.
-
مجلة العلوم الانسانية والطبيعية، د.يوسف موسى علي عبد الله أو عليقة. المجلد (6) العدد (9).
قائمة المراجع الأجنبية
-
Dewey, J. (1938). Experience and education. New York, NY: Macmillan.
-
Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected interviews and other writings. New York, NY: Pantheon Books.
-
Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York, NY: Continuum.
-
Habermas, J. (1987). The theory of communicative action. Boston, MA: Beacon Press.
-
Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
-
Ricoeur, P. (1976). Interpretation theory: Discourse and the surplus of meaning. Fort Worth, TX: Texas Christian University Press.
-
Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York, NY: Basic Books.
-
van Manen, M. (1990). Researching lived experience: Human science for an action-sensitive pedagogy. New York, NY: State University of New York Press.