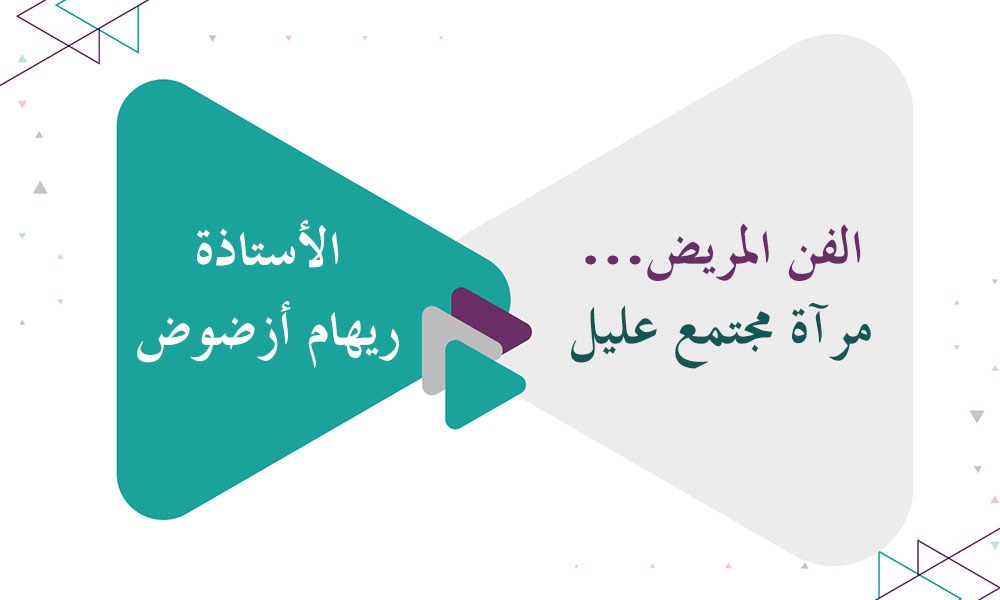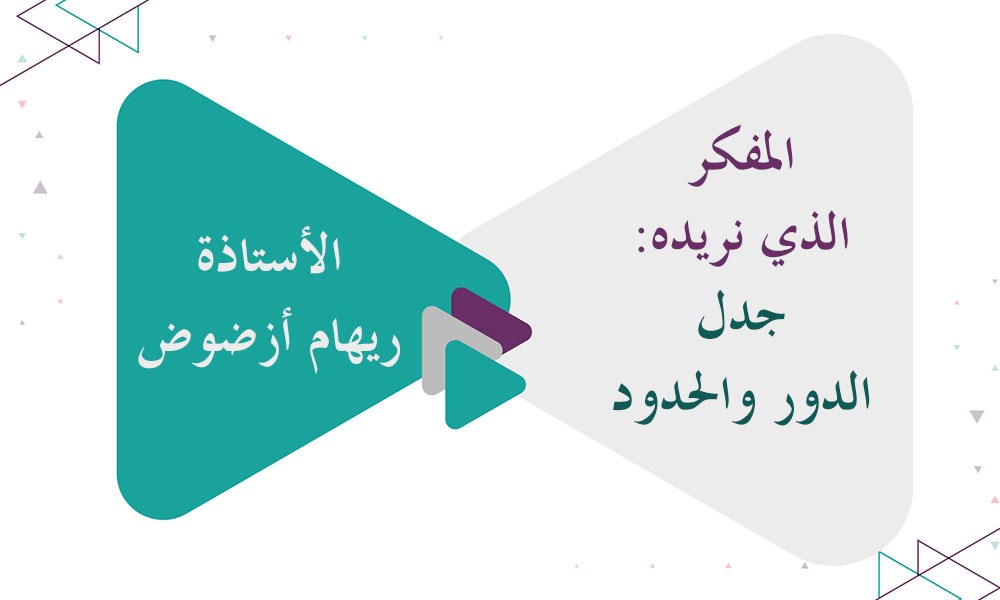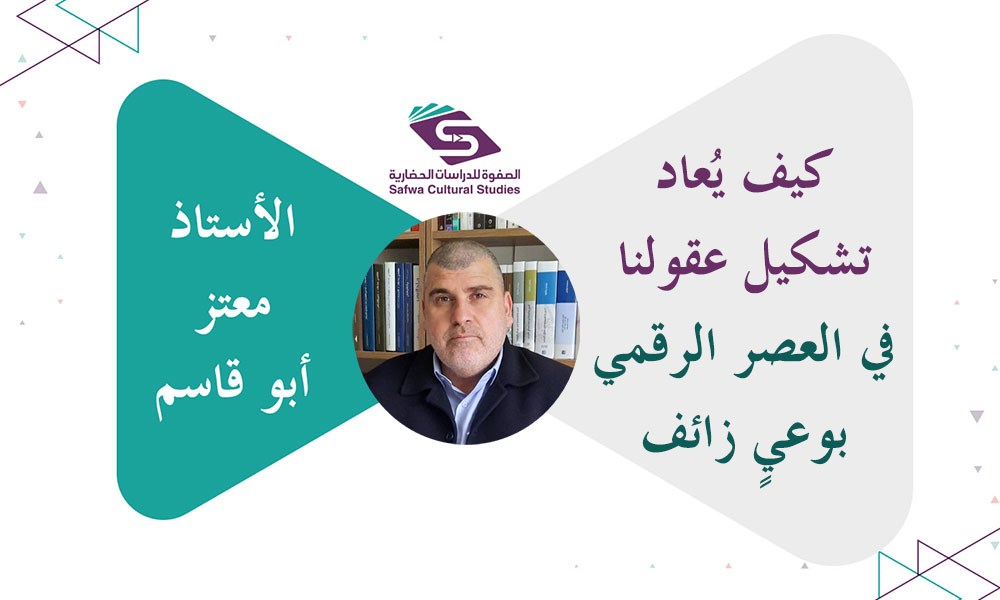فلسفة الماء: كيف تغزو الصين العالم بلا رصاصة؟
في عالم تتسارع فيه التحولات التكنولوجية وتتغير فيه موازين القوى بشكل دراماتيكي، يبدو من المفارق أن تعتمد قوة عظمى صاعدة مثل الصين، في جوهر تخطيطها الاستراتيجي، على حكمة نصٍّ عسكري كُتب قبل أكثر من 2500 عام. إن كتاب "فن الحرب" للمفكر والقائد الصيني "سان تسو "ليس مجرد أثرٍ تاريخي، بل هو بمثابة دستورٍ للفكر الاستراتيجي الصيني، وروحه الخفية التي توجه سلوك هذا التنين العملاق على المسرح العالمي. لفهم صعود الصين اليوم، لا بد من الغوص في أعماق هذا التراث الفكري الذي يمنحها صبراً فريداً ومرونة استثنائية، لفهم كيف لحضارة عريقة أن تحافظ على خيط استمرارية فكري يمتد لآلاف السنين ويشكل حاضرها ومستقبلها.
تستكشف هذه المقالة جوهر هذا الفكر، وتفكك مبادئه الأساسية، وتتبع تطبيقاته العملية في سياسات الصين المعاصرة، وصولاً إلى تحليل انعكاساته العميقة على النظام الدولي، وعلى موقع العالم العربي والإسلامي في خضم هذه التحولات الكبرى.
الجذور العميقة: "سان تسو "وإرث الحكمة الاستراتيجية
لم يولد كتاب "فن الحرب" في فراغ، بل كان نتاج حقبة مضطربة من التاريخ الصيني عُرفت بـ "فترة الربيع والخريف" ثم "فترة الدول المتحاربة"، حيث كانت الممالك الصينية في صراع دائم. في هذا السياق، ظهر "سان تسو "(اسمه الأصلي صن وو)، القائد والمفكر الذي خدم في "مملكة وو". وتُروى قصة شهيرة توضح عمق فلسفته القائمة على الانضباط المطلق وفهم الطبيعة البشرية، حين كلفه الملك بتدريب جواري القصر وتحويلهن إلى جيش مقاتل. عندما استهترت الجواري بأوامره الأولية، لم يتردد في إعدام قائدتي الصفين، اللتين كانتا من محظيات الملك المقربات، ليرسل رسالة صارمة بأن الأوامر العسكرية ليست مجالاً للتهاون. هذه الحادثة، التي تبدو قاسية، أرست مبدأه الأساسي: الوضوح في الأوامر والصرامة في التنفيذ هما أساس أي قوة ناجحة.
إن كتاب "فن الحرب" نفسه ليس مجرد دليل عسكري تقني، بل هو عمل يمزج بين الشعر والنثر، ويقدم حِكَماً مكثفة تصلح للسياسة والاقتصاد والمدافعات الحياتية كافة. ولعل سر خلوده يكمن في تركيزه على المبادئ العامة والمجردة للاستراتيجية بدلاً من التفاصيل الفنية المرتبطة بزمانه. فهو يتحدث عن النفس البشرية، والخداع، والصبر، وتقييم القوة والضعف، وهي ثوابت لا تتغير بتغير أدوات الحرب.
وقد عبر هذا الكتاب حدود الصين ليصل إلى العالم أجمع. ففي آسيا، أصبح المرجع الأساسي في تكوين القادة العسكريين في اليابان وكوريا وفيتنام لقرون. أما وصوله إلى الغرب في القرن الثامن عشر، فقد أحدث تحولاً تدريجياً في الفكر الاستراتيجي. ويُقال إن نابليون بونابرت اطلع على ترجمته الفرنسية، وأن براعته غير التقليدية في الحرب كانت نتاج تأثره بفكر سان تسو.
لكن التأثير الأكبر ظهر في القرن العشرين، حين وجد فيه المفكرون الاستراتيجيون الغربيون، أمثال ليدل هارت، بديلاً عن الفلسفة السائدة للمفكر الألماني كلاوزفيتز. فبينما قامت فلسفة كلاوزفيتز على المصادمة المباشرة وضرب العدو في "مراكز ثقله" أي مواطن قوته، دعا "سان تسو "إلى نقيض ذلك تماماً: تجنب القوة والبحث عن الضعف. لقد رأى ليدل هارت، بعد أن شهد المذابح المروعة للحرب العالمية الأولى، أن اتباع حكمة "سان تسو "كان ليوفر على أوروبا "بحاراً من الدماء" عبر إدارة الصراع بكلفة أقل وفاعلية أكبر.
مبادئ الحكمة في التطبيق: من النظرية إلى الواقع
يمكن استخلاص جوهر فكر "سان تسو "في مجموعة من المبادئ التي لا تزال الصين الحديثة، وخصومها على حد سواء، يطبقونها بوعي أو بغير وعي.
1. انتقِ حربك بعناية: يرى "سان تسو "أن أخطر قرار على الإطلاق هو قرار بدء الحرب. فلا يجب خوض حرب إلا إذا كانت في مصلحتك الحيوية، وفي التوقيت والمكان المناسبين. إن الدخول في صراع بناءً على الارتجال أو الانفعال أو سوء التقدير هو بداية الكارثة. ولعل التاريخ العربي المعاصر يقدم درساً قاسياً في هذا الصدد، فالحرب العراقية الإيرانية كانت مثالاً لحربٍ "عدمية" خاضها الطرفان بتوقيت خاطئ وحسابات غير دقيقة، وأدت إلى استنزاف البلدين وفتح المنطقة على مصراعيها للتدخلات الأجنبية.
2. تقبّل الخسائر المحسوبة: من يسعى لكسب كل شيء، يخسر كل شيء في النهاية. تقتضي الحكمة الاستراتيجية الاستعداد للتضحية بأهداف تكتيكية أو قبول خسائر جزئية ومحسوبة من أجل تحقيق نصر استراتيجي أكبر وأكثر ديمومة. المثال الأبرز على ذلك هو قصة فك شفرة "الإنجما" الألمانية من قبل البريطانيين في الحرب العالمية الثانية. فعندما علموا بخطة ألمانية لتدمير أسطول بريطاني حيوي للحلفاء، اختاروا بوعي التضحية بالأسطول بأكمله وعدم التدخل لإنقاذه، حتى لا يكتشف الألمان أن شفرتهم قد كُشفت، محافظين بذلك على تفوق استراتيجي حسم الحرب لاحقاً.
3. قاتِل بسيفٍ مُستعار: لا تعتمد على قوتك الذاتية فقط، بل تعلم كيف تستثمر قوة الآخرين لتحقيق أهدافك. يمكن أن يتم ذلك عبر التحالفات المشروعة، أو عبر "توريط" الأطراف الأخرى في صراعات تخدم مصالحك وتستنزفهم. لقد أتقن الأمريكيون هذه الاستراتيجية خلال الحرب الباردة، حيث قاتلوا الاتحاد السوفيتي بدماء شعوب أخرى في فيتنام وأفغانستان وغيرها، دون مواجهة مباشرة. وكذلك فعلوا في الحرب العراقية الإيرانية، حينما كانت استراتيجيتهم، باعتراف كيسنجر، هي "خسارة الطرفين"، فكانوا يمدون كلاً منهما بما يضمن استمرار الحرب واستنزافهما معاً.
4. كُن كالماء (الاستعارة المحورية): لعل أبلغ استعارة تلخص فلسفة "سان تسو "هي تشبيهه للجيش بالماء. فالماء هو ألين المواد وأكثرها مرونة، ولكنه قادر على اختراق أقسى الصخور. هذه الفلسفة تقوم على عدة أركان:
المرونة والتكيف: الماء يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه. كذلك الاستراتيجية الناجحة، يجب أن تتكيف مع الواقع والظروف المتغيرة، لا أن تحاول فرض قالب جامد عليها.
تجنب المصادمة: الماء لا يصطدم بالصخرة، بل يلتف من حولها. لا تواجه قوة خصمك مباشرة، بل ابحث عن الطريق الأقل مقاومة.
استهداف الضعف: الماء يتدفق دائماً إلى المنخفضات لا المرتفعات. اضرب خصمك في نقاط ضعفه، وليس في مواطن قوته. هذا سيؤدي إلى انهيار منظومته بأكملها بأقل تكلفة.
الصبر والتراكم: الماء يتجمع خلف السد، يحشد قوته بصبر وهدوء، حتى تأتي اللحظة التي ينهار فيها السد تحت ضغطه الهائل.
هذه الفلسفة هي التي تفسر الصبر الاستراتيجي الصيني، وقدرتها على التخطيط لعقود وقرون، بينما يخطط الآخرون لسنوات انتخابية.
التنين المائي: الاستراتيجية الصينية على المسرح العالمي
عندما ننظر إلى سلوك الصين اليوم، نجد أن "فلسفة الماء" تتجلى في كل سياساتها. إن صعودها الاقتصادي لم يكن صدامياً، بل كان تدريجياً وتكيفياً. لقد حولت نفسها إلى أكبر دولة رأسمالية في الواقع العملي، مع الحفاظ على الشعارات الشيوعية ظاهرياً، متجنبةً بذلك صداماً داخلياً مدمراً.
على الصعيد الخارجي، نرى الصبر الاستراتيجي واضحاً في قضية تايوان، حيث تتجنب الحرب المباشرة وتنتظر "إنضاج الثمرة" لتسقط في يدها بأقل كلفة. وكذلك فعلت مع هونغ كونغ التي انتظرت 99 عاماً لاستعادتها. إنها تتجنب استفزاز "جرح الكبرياء" وتفكر بعقل بارد لتحقيق أهدافها طويلة الأمد.
لكن المشهد الصيني اليوم يشهد تنازعاً بين تيارين: تيار "سان تسو "الهادئ الصبور، وتيار الحزب الشيوعي الثوري الذي يحمل في طياته نزعة صدامية، والذي يبدو أن الرئيس الحالي شي جين بينغ يميل إليه أكثر من أسلافه. لقد أصبحت الصين أكثر مجاهرة بقوتها وأكثر تحدياً للغرب، ربما لشعورها بأنها لم تعد بحاجة للمجاملات. المستقبل سيُظهر أي التيارين سيسود.
إن تحديات الصين هائلة. فعلى عكس الولايات المتحدة التي تتمتع بـ"حصانة جغرافية" فريدة، تجد الصين نفسها محاطة بعمالقة نوويين ومنافسين تاريخيين (روسيا، الهند، اليابان، باكستان). كما أنها تعاني من "اختناق بحري"، حيث تمر تجارتها عبر مضائق حيوية (ملقا، باب المندب، هرمز) لا تسيطر عليها. وهذا يفسر استراتيجيتها الحالية لبناء موطئ قدم في ميناء جوادر الباكستاني، وقاعدة في جيبوتي، وشراكة استراتيجية مع إيران، في محاولة لكسر هذا الطوق وتأمين شرايين حياتها الاقتصادية.
انعكاسات الصعود الصيني على العالم العربي
في خضم هذا التحول، أين يقف العالم العربي؟ إن لدى الغرب قلقاً تاريخياً مما أسماه هنتنغتون "المحور الكونفوشيوسي-الإسلامي". ومن جهتها، تدرك الصين الأهمية الاستراتيجية القصوى للمنطقة العربية والإسلامية، كمصدر للطاقة وممر للتجارة. لذا، فهي تتمدد بهدوء وتنسج علاقات اقتصادية متينة، كما يتضح من وساطتها الأخيرة بين السعودية وإيران، اللتين تعتمد عليهما في أمن طاقتها.
إن المشكلة التي واجهت العالم العربي في تاريخه المعاصر، كما يظهر من تجاربه المريرة، لم تكن نقص الموارد أو القوة، بل ضعف الوعي الاستراتيجي، والميل إلى ردود الفعل الانفعالية بدلاً من التخطيط طويل الأمد، مما جعله يدفع أثماناً باهظة لتحقيق أهداف صغيرة، أو للفشل في تحقيق أهدافه الكبرى.
أمام الدول العربية اليوم خيارات استراتيجية معقدة. فالحياد المطلق قد يكون صعباً، والانحياز الكامل لأحد الطرفين محفوف بالمخاطر. لعل الخيار العملي، كما تشير الحكمة الاستراتيجية، يكمن في "المنزلة بين المنزلتين": بناء علاقات متوازنة، والمحافظة على المصالح القائمة مع الغرب، مع فتح قنوات ومساحات مشتركة جديدة وعميقة مع الصين. إن الصراع بين الكبار يفتح دائماً نوافذ فرص للقوى الأصغر للمناورة وتحقيق مصالحها، شريطة أن تمتلك رؤية استراتيجية واضحة وعقلاً بارداً قادراً على قراءة المشهد الدولي بعمق.
إن تجاهل صعود الصين لم يعد خياراً. وفهم العقل الاستراتيجي الذي يحركها ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة حيوية لمن يريد أن يجد له مكاناً فاعلاً ومؤثراً، لا مجرد ورقة تتقاذفها الأمواج، في عالم القرن الحادي والعشرين الذي يتشكل أمام أعيننا.
ملاحظة: هذا المقال هو صياغة تحليلية وموضوعية للأفكار والرؤى التي طرحها الدكتور محمد المختار الشنقيطي، أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر، خلال استضافته في "بودكاست الشرق". وقد تم تنظيم الأفكار في نسق مقال مستقل لتقديمها للقارئ الكريم في قالب متكامل.